عشاق الفلسفة موجودون في كل عصر، وهم كثيراً ما يتوقون إلى قراءة تأملات الفلاسفة حول قضايا الوجود والخير والجمال، وهم عادة ما يحبون العيش في دهاليز مذاهب الفلاسفة، ينعمون بفك رموزها واصطلاحاتها، ويشعرون بالسعادة الغامرة، مع القدرة على تفسير آراء هؤلاء الفلاسفة، وفهم أبعادها، ومقارنة آراء هذا بآراء ذاك حول هذه الموضوع، أو غيره من الموضوعات التي تناولوها في مذاهبهم.
ورغم هذا، فإن أغالبية البشر الآن أصبحوا يتساءلون عن جدوى الفلسفة بهذا المعنى النظري، وعن جدوى المذاهب الفلسفية، وعن جدوى ضرورة العيش بين المصطلحات المجردة للفلاسفة.
يثير عنوان هذا الكتاب «العلاج بالفلسفة» للدكتور مصطفى النشار دهشة القارئ، الذي عرف صوراً متعددة من العلاج الطبي والنفسي، لكنه لم يسمع يوماً عن العلاج الفلسفي، فهل هناك علاج يمكن أن تقدمه الفلسفة للإنسان، خاصة في ظل تفاقم مشكلاته الصحية والنفسية والاجتماعية والسياسية والبيئية؟
يشير الدكتور النشار إلى أن العلاج بالفلسفة قديم قدم تاريخ الفلسفة، إذ لم تنشأ الفلسفة إلا للإجابة عن تساؤلات جوهرية أرّقت الإنسان وأرهقت عقله، وأثرت في أدائه في الحياة، ولم تأته الإجابة إلا عن طريق فلاسفة، نجحوا من خلال تأملاتهم وعقولهم الفذة في أن يصلوا إلى إدراك الكثير من الحقائق حول الوجود، وماهية الإنسان، وما يعانيه من مشكلات.
وفي هذا الصدد، يمكن أن نشير إلى الدور الذي قام به فيلسوف مثل سقراط، في علاج معاصريه، حينما نبّههم إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أنهم لم يبدأوا بمعرفة حقيقة أنفسهم، وحقيقة ما يدّعون العلم به، قبل أن يتوجهوا إلى الآخرين، معلنين أنهم قد عرفوا كل شيء، وأمسكوا بكبد الحقيقة، ونجح سقراط في علاج مدّعي العلم، بأن كشف لهم زيف ادعاءاتهم، فضلاً عن أنه أوضح لهم أن طريق المعرفة الصحيح، يبدأ بأن يدرك كل منا حقيقة أي موضوع يتحدث فيه.
وتوالت بعد ذلك – كما يوضح الدكتور النشار – صور العلاج الفلسفي لكل قضايا الإنسان ومشكلاته عبر تاريخ الفلسفة، فقد واصل أفلاطون طريقة أستاذه العلاجية، فأسس الفلسفة كعلم للحوار، وأكد على أن علاج أي مشكلة يكون دائماً عبر الحوار بين أطرافها، ذلك الحوار الذي يتفقون منذ بدايته على أنه طريقهم للوصول إلى حقيقة الموضوع الذي يختلفون حوله.
أما الدرس الثالث في العلاج بالفلسفة فقد قدمه أرسطو، حينما وجد أن المعارك الفكرية بين سقراط وأفلاطون من ناحية، والسوفسطائيين من ناحية أخرى، وبين هؤلاء وبين عامة اليونانيين، من ناحية ثالثة، إنما أساسها الخلط في استخدام التعابير اللغوية، والغموض في الاستدلالات العقلية، حينئذ كتب أرسطو مؤلفاته المنطقية، مميزاً بين الطريق الصحيح في التفكير والاستدلال، وبين الطرق الخاطئة في استخدام اللغة.
والطريف – كما يرى الدكتور النشار – أن الفلسفة القديمة بعد أرسطو قد تحولت برمتها إلى فلسفة علاجية، فكل التيارات الفلسفية استهدفت التماس طريق لسعادة الإنسان، وسط ظروف شديدة الوطأة من حروب وصراعات، تلاعبت بأقدار الفرد، لدرجة أن تغير المثل الأعلى للإنسان في ذلك الزمان، وركز أبيقور في فلسفته العلاجية على علاج آلام النفس لأنها، في رأيه، أبشع من آلام الجسد، فإن كان الإنسان يتألم ويعاني القلق، خوفاً من الموت أو من المصير، فإنه بالعلم والفلسفة يمكنه التخلص من هذا القلق.
أما الرواقيون فقد ضربوا أروع الأمثلة على أن الفلسفة فيها الشفاء من شتى أنواع القلق، وكل أصناف الهم والألم، ولعل أروع ما كتب في الزمن القديم عن العلاج بالفلسفة ما كتبه بؤثيوس في زنزانته خلال الشهور التي سبقت إعدامه عام 524 ميلادية، حيث كتب كتاباً بعنوان «عزاء الفلسفة» فيه أساليب ناجعة في علاج النفس القلقة.
ويتواصل العلاج بالفلسفة مع بداية العصر الحديث، حيث لاحظ الفلاسفة سيادة جمود أحبط العقل، فأعادوا إلى العقل رونقه وأطلقوه من عقاله، فاصطنع ديكارت الشك، وجعله علاجاً لجمود الفكر، ولا يتوقف العلاج بالفلسفة على الصعيد الفردي، وإنما يتعداه إلى الصعيد الاجتماعي والسياسي، فمعظم الفلاسفة لهم مذاهبهم الأخلاقية والسياسية، التي تعالج أمراضاً اجتماعية وسياسية، تعانيها مجتمعاتهم، ولم تكن رؤية فلاسفة عصر التنوير (فولتير – ديدرو – مونتسكيو) النقدية إلا محاولة لإصلاح الأوضاع السيئة وصنوف الظلم الاجتماعي وعدم المساواة التي عاناها مواطنو أوروبا في ذلك الزمان.
المصدر: الخليج












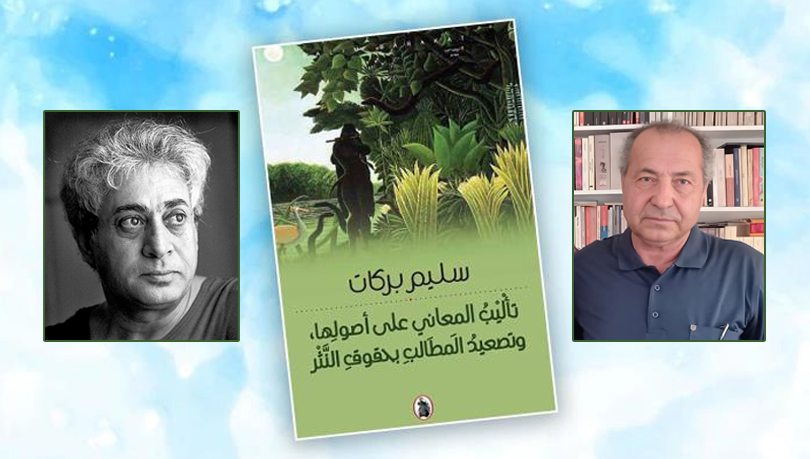




0 تعليقات