يتمتّع نزار قباني برنين "الحضور"، حضوره الآسر، باستحواذه على المتلقي، أقصد بغياب الشِّعر وحضور الشَّاعر، هذا لا يعني أنَّ قصيدة نزار قباني لا أهمية لها بقدر ما أنَّ رنينَ الاسم والجسد والصوت يعصف بحضور القصيدة؛ ليكون الحضور حضور الشّاعر، فتأتي القصيدة إلحاقاً لهذا الحضور الباذخ، كما لو أنَّ حضور الشاعر هو القصيدة، فالقصيدة لا تعرف الاستقلالية عن جسد الشاعر، عن جسده الحاضر، عن حضور جسده، عن صوته، عن تنفُّسه، ولهذا لا غرابة في القول: إنَّ قصيدة نزار قباني ما فَتئت سليلة الصَّوت والرطوبة، قصيدة المعنى الواضح، القصيدة التي تُفسِّر نفسها بنفسها، القصيدة التي تغفو ما أن يغفو الشاعر، إذ تكتسب القصيدة معناها، دلالاتها من الشَّاعر ذاته، هذا التطابق بين الشَّاعر وقصيدته هو الذي يفسّر قوة الرنين الذي يتمتع به نزار قباني في ذاكرة المتلقي، بهذا المعنى فإنَّ نزار قباني يعيد إنتاج/ تمثيل الشّاعر الشفاهي، شاعر الصوت بامتياز في راهن الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، حيث تأتي الكتابة، كتابة القصيدة، بوصفها صوناً للصوت من الضياع ليس إلا.! ومن هنا يمكننا إدراك شغف الشّاعر بإلقاء القصيدة، فالقصيدة لا تكتمل إلا بالصوت، بتصويتها، بقذفها من سطح الروح "ما أشقى القصيدة التي لا تُتلى... إنَّ طعمها في الحلق يصبح كطعم العصفور الميت"([1])؛ فالقصيدة بنت الصوت وسليلته؛ لأنها تتشكَّل أو تكتسب به تشكّلها النّهائي، بالصوت، يتحقّق هويتها، حيث يسير دالُّ القصيدة إلى مدلوله دون رعف أو التواء،، ليحدث ذلك التطابق الأثير على قلب الشّاعر، حيث كل دالٍّ يأخذ بخناق مدلوله، فتكتمل هوية المعنى، معنى القصيدة، فتستقرُّ عليه، ويستقرُ الشّاعر في الوقت مع ذاته، هويته، يطمئنُّ على كونه هو هو؛ إذ يسمعُ ذاته، فلا يغدو ثمة فارق بين القصيدة والشّاعر، فالقصيدة هي الشّاعر والشّاعر هو القصيدة، حيثُ تحيلنا "القصيدةُ – الصّوت" إلى الشّاعر الذي به يتحقَّق المعنى، فالقصيدة لا معنى لها إلا من خلال الصّوت، صوت الشّاعر؛ إذ تكتمل هويتها وتصبح كائناً جديراً بالتقدير. هكذا: "ما أشقى القصيدة التي لا تُتلى"، من حيث إنّها تفصل بين الشّاعر وصوته، صوت الشّاعر إليه، ومن هنا القسوة التي تحياها القصيدة المكتوبة؛ لأنّها "تُتلى"، تظلُّ حبيسة صمت الكتابة؛ فهي لا تتجسَّد من خلال صوت الشّاعر وبه، فصوت الشّاعر، أعني حضوره الجسدي أثناء الإلقاء، هو الذي يمنح القصيدة المعنى.
إلى هذا الحدِّ شغف نزار قباني بقراءة القصيدة، إلى هذا الحدِّ عشقَ الشّاعر التماثل بينه وبين قصيدته، فالقصيدةُ قصيدةٌ حين وحين فقط يسمعُ الشّاعر عبر قراءتهـ(ـا) صوتَهُ، ذاتَهُ، ومن هنا يمكننا تحويل أو ترجمة عبارة نزار قباني: "ما أشقى القصيدة التي تُكْتبُ"، فالكتابة بطبعها شقيّة، لأنها تلغي الحضور، حضور المعنى وحضور الشّاعر ذاته معاً؛ فهي إذ تعصف بكلِّ ذلك؛ فإنّها تحدث ذلك التباعد بين دالِّ القصيدة ومدلولها، بين الشّاعر وصوته، وهذا يشكّلُ خطاً أحمر في عرف شاعر جماهيريٍّ مثل نزار قباني، شاعر الصَّوت بامتياز، ومن هنا يأتي توصيفنا لقصيدة نزار بأنّها قصيدة الصَّوت، القصيدة التي تنجح على نحو فائقٍ في تفسير ذاتها بذاتها، أي تنجح في ترتيب المعنى وتفسيره؛ لأنها تتبع عادات الصوت وتقاليده دون فرض العناء على المتلقي لاستنطاقها، حتى وهي تمارس كينونتها في إهاب الكتابة؛ فكتابة نزار الشّعرية أو النثرية هي تلك الكتابة التي تحتفظ بوهج الصّوت ودفئه ورغبته في التواصل، لا الكتابة التي تنزع نحو البرودة والانفصال والصَّمت، لذلك يكتب نزار قباني إمعاناً في الشغف بالصوت ودوره في نقل القصيدة من طور "الكتابة – الموت" إلى طور "القصيدة - الصوت"، يكتب: "فالقصيدة المكتوبة على الورقة شيءٌ.. والقصيدة المكتوبة على جسد الناس شيء آخر.. القصيدةُ قبل أن تلاقي النّاس، ضفدعة اختبار ميتة، وما أن تلاقي الناّس حتى تدبُّ الحياة في أطرافها، وترتعش، وتقفز إلى الماء"([2])، كما لو أنَّ الشّاعر الكبير لا يعترف بهوية "القصيدة" إلا حين تُقرأُ، وله عذرٌ في ذلك من حيث إنَّ القصيدة المكتوبة، القصيدة الشقية، "القصيدة – الكتابة" تنسف حضور ت، حضور الشّاعر وتقطع العلاقة بينه والمتلقي؛ فهي تواجه العالم دون وساطة، تقذف نفسَها بنفسِها، ولهذا فهي ضفدعة ميتة؛ لأنّها تكرِّس الغياب، أي قصيدة تحيا دون شاعرها؛ ولهذا تبقى مرفوضة، والأصل أنّها سليلة الشّاعر، منه وإليه: "في الأمكنة الضيقة أرى صوتي.. أعانقه.. أشمُّ رائحته"([3])، وهنا أيضاً ينحاز الشّاعر الكبير إلى نعمة الصَّوت، إذ يضاعف الشّاعر من إجلاله للصوت، للقصيدة وهي تتلبَّس صوت الشّاعر، روحه، حيث تكتمل القصيدة هويةً من خلال التطابق بين الشّاعر والقصيدة، وباكتمالها تكتمل الشّاعرية حيث ترتدُّ القصيدة على صاحبها؛ لتعلنه شاعراً، وتنصبه إمبراطوراً على شعرية الصوت دون منافس.
هذا هو نزار قباني، الشّاعر الذي عَشِقَ القصيدة، وهي تُتلى، إذ بتلاوتها تحضر الروح وتغدو أشياء العالم في متناول الشّاعر: "تصبح يدُ حبيبتي مكان يدي.. وفمها كتاباً أقرؤه قبل أن أنام.. ودبُّوسها المنسي على الطاولة، حمامة لا تريد أن تطير"([4]). وبذلك تكرِّسُ "القصيدة – الصوت" صوت الشّاعر ذاته، وفي ذات المتلقي، فالنقص كل النقص في القصيدة - الكتابة، والكمال كلّ الكمال في القصيدة - الصوت حيث: "الأماسي الشّعرية هي المرايا التي يرى فيها الشّعراء وجوههم"([5]). استناداً لذلك يمكن القول: إنَّ قوة القصيدة لدى نزار ليس في صيغتها المكتوبة، وليس في كونها قصيدة كتابة، وإنما في كونها قصيدة - صوت، القصيدة التي تتضافر مع صوت الشّاعر في الاستحواذ على المتلقي، وهذا ما يفسِّرُ الطابع العفويّ لقصيدة نزار قباني، الطابع القوي وهي تُقرأ بصوت الشّاعر، كما لو أنَّ هذه القصيدة على أهبة الموت بغياب شاعرها، قصيدة تنفر من صيغتها الكتابية؛ لأنّها وليدةُ عفوية نزار ورهافته، نزار العاشق لميتافيزيقيا الصَّوت حتى الموت، الصوت الذي يؤبِّد حضوره في جسد المتلقي، لتبقى القصيدة صدى صوته الآخذ بالتبعثر والانتشار والتلاشي!
([1]) ــ نزار قباني: ما هو الشعر، بيروت: منشورات نزار قباني، ط1، 1981، ص 173.
([2]) ـــ ما هو الشّعر، ص 133.
([3]) ـــ ما هو الشّعر، ص 134.
([4]) ـــ المصدر نفسه، ص135.
([5]) ـــ المصدر نفسه، ص 136.








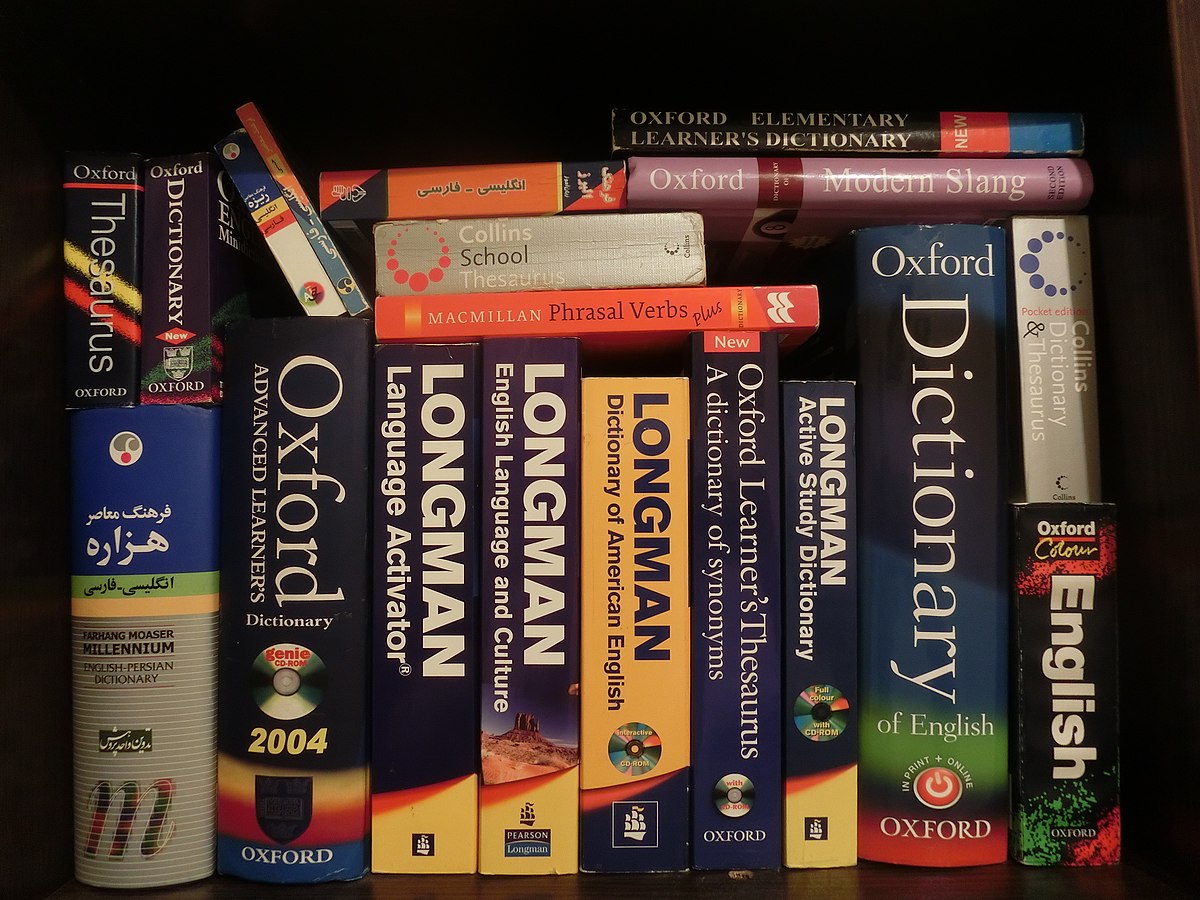









0 تعليقات