قصيدة الرغبة الناقصة... خالد حسين ومغامرته الشعرية في "نداء يتعثر كحجر"
أن نكتب هو أن نقول ما يحيلنا إلى الوجود لنؤكد فيه وجوداً أبدياً لنا. فالكتابة تحريرٌ للقول من خاصيته الوقتية، ومن ملابسات الحالة الطارئة، سعياً إلى تلك اللحظة التي لطالما نتمناها في لاوعينا، وهي المتمثلة في تأكيد رغبة البقاء، مغايرين لما نحن عليه من تحول مؤلم أو ضعف. لأن الكتابة تتحرر من تقاليد الزمان والمكان المعروفة، كونها ترسم في سياق أسلوب معين، تؤمم ذاكرة مستقبلية، وتتولى مثل هذا العبور إلى مشتهى الرغبة، نوعاً من الالتفاف على الآني.
دون ذلك ، كيف يمكن تفهّم مغزى الكتابة التي تفتح بنا وجوداً عائداً إلينا وباسمنا وما يتجاوزنا، على وجود يندرج في المطلق، وتعزّز فيه متعة نتوخاها بصيغ مختلفة ؟
في هذا المنحى، ماالذي يمكن للشعر أن يقوله؟ مالذي يمكننا قوله لحظة التعبير بالشعر قولاً وقد استحال كتابة ؟ ألا يعدو في الحالة هذه فلترة الكتابة بالطريقة التي تغازل النجوم، كما لو أنها موجودة دون سمائها، أي في ذاتها المحضة، وقد تأممت في سماء روح كاتبها، واستضاءت في ضوء رغبته، وهي أن يكون أبعد مما هو متلمَّس في كتابة ما أشبهها بسكَّة قطار في صلابتها، والشعر ما أشبهه بالطيران الحر، حيث يهدر قطار الروح محرَّراً من السكة؟
ربما نكون هنا إزاء حلم الروح في الامتداد إلى المستقبل، إنما بدفع مستحقاته، حيث قول الشعر يعادل رغبة حلْمية، تمثّل ذلك الطفل الممتلىء بالحياة خارج حدودها، طفلاً أبدياً للآتي.
وأزعم هنا أن أولئك الذين يقولون الشعر، إنما يتنفسون تلك الطفولة التي تجيز لهم حضوراً أبدياً في الوجود وهم يشعّون نجوماً، ومن يكتبون عن هؤلاء، يمارسون نوعاً من الرياضة الروحية الخاصة: إنهم يعيشون ألعاب قوى ليكونوا أكثر قابلية لأن يستمروا في الوجود من خلال ما يتبينون في قراءة الشعر ما يجيز لهم بقاء، كما في قراءة فالتر بنيامين لبودلير، كما في قراءة هيدغر لهولدرلين، كما في قراءة دريدا لسيلان...إلخ، لنكون إزاء رغبة في رغبة..
وفي لقاء المجموعة الشعرية للباحث والناقد والمترجم والشاعر معاً الدكتور خالد حسين، ثمة ما يستوقف القول للنظر فيه، لتبيّن وجهته، في حدود الممكن قراءة، أو محاولة قراءة ما يمكن تبينه، وهو مقرَّرٌ شعراً، وأعني بها: نداء يتعثر كحجر، والصادرة حديثاً عن منشورات رامينا في لندن، 2023، وفي مائة صفحة ونيّف.
خالد حسين باحث، ناقد وشاعر، كما تقدَّم، وحين نقرأ من بين المعرَّف به: شاعراً، ماالذي يفصله عما يعرَف به وعليه بلغة الكتابة النطاسية، الكتابة المميَّزة بدقتها هندسياً، كتابة لها قواعدها منهجياً، وقد تعدّت ذلك لتصبح خارج المنهج، خارج الهندسة ذات المعايير الوضعية، وهي تقرّر هندستها الخاصة: هندسة الروح. بتعبير آخر: ليكون الناطق ذلك الطفل الذي يسبح في الأبدية متحرراً من كونه الراشد والمحمول بعمر يشكل عقوداً زمنية، وما لها وفيها من أعباء؟!
أن يطرَح نفسه شعراً، كما هو المقروء في الشعر عموماً، وفي هذه المجموعة، وله حيوات وتجربة سابقة في بداياته: في التسعينيات، وعبر قصائد منشورة هنا وهناك، هو أن يتقدّم برغبة لها إمضاءة متعة في كسر الوجود الجليدي، وقد استعاد طفولة متبصرة لتلك النجوم التي تضيء عليه ليل حياته، ليقول ما لم يستطع قوله في حالة كونه ناقداً، باحثاً، رغبة حلْمية مقرَّرة.
في " نداء يتعثر كحجر" يتقدم بما أسمّيه بـ"قصيدة الرغبة الناقصة"، حال القطْع الناقص، على وجه التحديد، لأن الرغبة دائماً تسمّي جانباً منها، وجهاً فيها وهي وجوه كثيرة، مساراً ما، وثمة مسارات، لتكون المتعة الروحية محققة، ليكون ترجمان القول الشعري رموزاً، صوراً، فتْح ممرات لأزمنة وأمكنة لتكون عوناً له على مفاوضة وجوده الذاتي وفي ذاته وعبوراً لها، ليعيش تحولاً في مكاشفة ما صعب عليه قوله في الكتابة النقدية.
وانطلاقاً من هذا المفهوم: قصيدة الرغبة الناقصة، يكون الآتي في إهاب الوعد، وإمكانية المضي شعوراً بالمتعة والاستزادة منها. تحرراً من ثقل ما لا يخفي شبحه، ونشداناً لمأمول ما يشدنا إليه طيفه.
في حضرة المجموعة
كما نوهتُ: المجموعة الشعرية الآنفة الذكرة تتعدى المائة صفحة، وترسم خريطتها الفهرسية، وهي تسمي عناوينها الداخلية. واللافت أن الفهرس جرت إزاحته لتحل مفردة" تضاريس " محله، وهو ما يستدعي إضاءة دلالية، حيث التضاريس بمفهومها الجغرافي تدشن عالماً بمعايير الذائقة الجمالية للشاعر، وتتقدم بكوكبها، بأرضها، بسمائها، بكائناتها، بأشيائها وقد أطلق عليه الشاعر أسماءه التي تعنيه ليكون هنا المخلوق كائناً والخالق كائناً له قدراته النافذة الأثر.
وليس من غرابة في هذا المنحى، حين تقوم " تضاريسه " على ثالوث منعطفي: ثلاثة منعطفات، وما تدعو إليه في بنيتها التضاريسية والسيميائية، حيث المنعطف تحويلة طبوغرافية، نسج لمكان آخر في ضوء معايشة مكان سالف، وقد نُظِر فيه شعراً، وتلك هي الرغبة في المغايرة.
سوف أحاول متابعة جوانب مما تقدم، وفي حالة يقظة، تجاوباً مع مقولة بنيامينية( وظيفة الناقد هي اليقظة )، لأن الشاعر يطرح حلمه. ومن المؤكد أنني لن أكون مفسّر أحلام، وإنما أحاول التوقف عندها في لغتها، ومالذي يقرّره الحلم وفيه من الصحو ما يحفّز على قراءته .
ما هو قابل للنظر فيه
بداية، أشير إلى أن مجموعة " نداء يتعثر كحجر "متخم بالكائنات ثلاثية الأنواع: برّية، بحرية، برمائية، ثمة العناصر الأربعة في الطبيعة، والشاعر في محاولته هذه، إنما يحاول تنفسَ الطبيعة كما لو أنه إياها، وما في هذا الانفتاح عليها من إدانة لوجود قائم، من مقاربة نقدية له، وبلغته ، ولا أدري أي حضور روسوي " نسبة إلى جان جاك روسو " ليكون هذا المتنزّه، وهو في بلده أصلاً: سويسرا، ليعزز انطلاقته الشعرية متوحداً مع متخيله الروحي هنا؟!
وبدءاً من العنوان العام للمجموعة، يكون النداء ما ليس مسمى لأي كان، ولكل من يعيش هذه الحالة، فالنداء لا يعرَف كنهه، ولكنه يخرج عن الكتابة، ويتردد صداه هنا وهناك، وبوصفه صوتاً ما، ولا بد أنه يحمل طيّه رسالة أو ما يشبهها، فثمة حاجة إليه، حاجة مستقبلية، حاجة مقررة في ضوء حمولة مكابدة تخص موجوداً ، عمراً، حياة، بشراً متعِبين...إلخ، وهو لا يخفي "جرحه الذي يتعقبه، كما أنه يتبينه وقد استحال ذا خاصية جمادية: تعثره كحجر، وفي الحجر ما يُسمى، وهو في خفة وزنه، فهو ليس صخرة لتثبت في المكان، إنما ذلك الحجر المحمول باليد أو المقذوف ضمن مسافة، أو الذي يكون في قبضة اليد، وهو هنا في قبضة الروح الشاعرة.
أكثر من ذلك حيث العنوان موصول بما يحفز على السؤال، أي: اشتباكات سردية في إهاب الشعر، وما في ذلك من تحويل في المعنى، حيث السرد داخل في لغة الكتابة، والشعر معلوم عنه أنه لاسردي، وفي مفردة" اشتباكات " ما يخرج المعلوم والمتداول عما يعرَف به، تعزيزاً لانعطافة اسمية بداية، ومسار تحول في الشعر راهناً، جرّاء المستجدات، كما لو أن الشاعر هنا يستجيب للمتغيرات، ويرفع الحدود عما هو حدودي في الشعر معنى وحدوداً.
في المنعطف الأول، حيث تتسلسل عناوين داخلية ولها أرقامها، وهي بذلك تشكل مشاهد تحوم هنا وهناك، ولها إحداثياتها المتداخلة والمتمايزة في آن.
أورد هنا ما يخص عنواناً في هذا المنعطف، عنواناً يُسمّي في الشاعر بحيرته الرمزية:
البحيرة
زمن خريفٌ،
إذ تنعطف أطراف النهار على أسرار البحيرة.
وهذه الجبال لا تتقن سوى الطعن!
الغيومُ-إناثٌ يمِلنَ تحت وطأة الشغف، إناث يتساقطن قطناً، البحيرة-
غمازة الأرض، تومض بنداءات للآلهة أن اهبطي- حيث كانت يوماً أعشاباً
حوشية أو أحجااً تودعها الكينونة ألغازَها..
خريف ذهبيٌّ وعلى ضفة العشب غزالتان تمتحنان النسيمَ في رغبته وتدعان
الآلهة في صخب الصمت ..! . ص11
ليس من تفكيك حسابي لهذا الوارد هنا، إنما محاولة معايشة نفسية، بعائدها الروحي: ثمة الأرض، ثمة السماء، ثمة ما بينهما، وثمة التعابير التي تصاغ شعرياً. إنما في المتن، إن جاز القول، ثمة أنثنة الوجود، وهي بخاصيتها التي تحث على التوالد، على الخصب والعطاء، على ذلك الطقس: طقس العود الأبدي، وما في ذلك من علامات تتقابل، وتضيء جانباً من معاناة الروح القلقة للشاعر، وفي الوقت نفسه، جانباً من بصيرة رؤية له في استقدام الآتي. فأن تكون حالة التأنيث علامة فارقة لهذا المشهد الشعري، إنما هي ترجمان أشواق الغد، رهاناً على وجود.
الوصف شغال بالمعاني، بدءاً من طلاقة دلالات " البحيرة " وما يستحضر الزمن وصفته، والتالي عليه. نحن إزاء مشهد اللعب بالكلمات، ولكنها معزّزة بمواقعها رمزياً، إنها، من حيث المكاشفة تميط اللثام عن الكثير من مكنونات الشاعر، وهي في أن يكون ما ليس عليه، حيث الوجود ليس ما هو عليه في الجاري وصفه، إنما ما يصدم الروح. وليس للشعر إلا أن يقول " لا " دائماً، إذا أراد لنفسه ديمومة، ولشاعره قيمومة حضور، لهذه الـ" نعم " الرسمية الثقيلة الوطء.
هناك مشهد آخر في المنعطف نفسه، وهو مدرج تحت عنوان " سفوح، كباش ولسان معضوض"
وفي مقطعه الثاني:
أناديكَ " كوجرو !"...لأوْنس الجلاميدَ في عزلتها، وأروّض هذع السفوح بقرون
كباشك، حينما رميتُ ندائي تفاحة بين يديك، كنتَ تلقّن الذئبَ أن يكون
ذئباً، وأن يكون نديماً لظلك ، هناك...في تلك الفجاج كنت أتخفّى كجناح الريح
عن يديك، فأرمي بروحي في أن أنين الناي لأغدو فراشة تحط على رموشك، وأتلو
جسدي أقماراً على شرفة ليلكْ. ص34
لم يعد الشاعر الذي كان هناك، كما هو، فهذا النداء الذي يتركز على الرحال" كوجرو " وهو المتنقل بين الأمكنة، ربما إشارة ما إلى نفسه أو سواه، في زمن لم يعد ممكناً الرهان على مكان ثابت، إنما ثمة ما يتركز على " غريزة اللا أمكنة " إن تجاوبنا مع الأنثروبولوجي مارك أوجيه، وعنف المعيش اللامكاني، جرّاء تحولات كبرى في الوجود الملموس. هناك يكون الرحال مصطحباً عالمه وما يميّزه، حيث تقوم السفوح، حيث الكباش تكون، وهو العالم الرعوي الخاص، عالم الطبيعة التي تهذب بلغة الشاعر ما هو صادم، وما هو محفّز على استدعاء المنشود، وفي مفردات لا تخفي مهامها الاستبصارية: فيما يخص جمادات قائمة "جلاميد: الصخور الضخمة" السفوح بوساعتها، الكباش، وهي في منحاها الجنسي وسطوة التسمية، والفجاج ومزالقها وعوائقها، والريح وقابلية المجابهة، والناي بنفخته الروحية، والفراشة بخفة التحليق...إلخ .
في المنعطف الثاني ما يعمّق أثر الأول
يستحضر جنس نباتي، شمّي، وله ملمس ناعم، يخص الروحي فينا، وأنا أورده بعنوانه " رائحة الخزامى " وطيّ العنوان الذي يبث أثيره الروحي، وما ينتمي إليه نسَباً شعرياً:
أيها البحر البعيد...
لا حيلة لي سوى أن أحقن الروح ببهائك ، أطارد رائحة الخزامى والحرمل في
تضاريسك، يأخذني بعيدُك ِ إلى حيث تشتهي حقول الرغبة، لا حيلة لي إزاء
منعطفات القول الفاتكة في هسيس خطابك ِ !. ص 42
من البحيرة هناك، إلى البحر هنا، ثمة الاتساع، وثم الاشباع الدلالي، وقد أعِدَّ ليكون أكثر استيفاء بما هو مأمول في رغبة الشاعر، حيث الولادة المستمرة بعمقها وقاعها العصي على المقايسة، ما يكون رحماً أرضياً، ويقبل الانفتاح ، التكاثر، الاستقطاب لمحيطه، ما يحفز على السفر، ما يقبل التحدي، وما يكون معزّزاً لقول المتذوَّق بمفرداته التي تجمع بين عناصر مختلفة، وبإمضاءة الشاعر، في مشرحة الصورة الشعرية، وإحياء المغيَّب أو المنفي، فثمة لغة حرب في قول الشعر كما هو المقروء في " منعطفات القول الفاتكة "، ولكنها الحرب التي تستدعي سلماً وما أصعبه.
ربما هكذا نتلمس في " شجرة "
شجرةٌ
تضيء أيامنا،
نشعلها بهسيس الكلام
غالباً ما نترك تلك الشجرة في أرواحنا
تساؤلات ٍ عن غرابة هذه العتمة ...!!. ص 49
ما يربط بين الخزامى والشجرة، هو التدرج في القول، هو الوعي الشّعري بالمكان الموصوف وقد ازداد رحابة وصفاء صور: الشجرة الأكثر حضوراً وكثافة أبعاد، حيث الشجرة كرمز كينوني، إشهاري بعميق المرئي، شهادة حية وانعطافية من جهتها على مأساة قائمة، حيث العتمة تقول ما يمكنها قولها تجاوباً مع منطوق الشجرة بالذات، وما يدعو إلى ترميم وجود قائم، إلى تجاوز المشروخ فيه، أو ما هو متصدع هنا وهناك، كما هو المرئي أنى التفتنا .
في المنعطف الثالث: هل من زاوية كاملة؟
ثمة ما يؤسس لمأساة وليس لملهاة في بنية القول لدى خالد حسين، إذ إن الجمهرة الكبرى من الاحتفاءات بعالم زاخر بالعناصر التي تنتمي إلى عوالم مختلفة، لا تبعث على التفاؤل في ضوء ما هو قائم، فثمة جرح روحي مقَرٌّ به لدى الشاعر، ولا بد أنه مستمر في النزف، وفي تلوين مفرداته، حيث الأوجاع متنوعة وتقر بوجود ما أثقله وما أفظعه كذلك من وجود:
ليلٌ يغوص في شهقة أخيرة
نداء يتعثر كحجر
في الفقرة 2
أنت ِ
امرأة ملتبسة ككل النساء اللواتي يحركن الكون بنظرة مغتلمة، ذئبةٌ تحيط
بالتضاريس الوعرة، يقول عاشق محيط.
أتمهل قليلاً: كيف لي أن أتجاوز ذاك الصدْع المخيف الذي ينحت تاريخك ِ،
التاريخ الغامض لجسدكِ .
با إلهي الوسيم، انظر: كيف أبدو كريشة تتلاعب بي الريح...!!
إنها مأساتي أيها الإله ! . ص 66
هل من مدعوة لاستشارة من هو في مقام فرويد، يونغ، ولاكان، لسماع ما هو مكبوت، ما هو معنّى، أو ما هو كاتم للصوت، زمنياً، ويستمر في فعل القتل لما هو وجودي، ويحفّز على الوجود، والذي يعاود الشاعر بمفرداته النظر فيه، بصور شعرية تتداعى وتتفاعل معاً؟
ما يقابله بالإله، أي إله يكون إن لم يكن ذاك الذي يعيشه يومياً، وهو في مبعدة عما يهدىء روعه، وهو المتطاير، المقذوف هنا وهناك، وهو بروحه في مكان وليس مكاناً ينام فيه" نوم قرير العين هانيها "، إنما موجوع الروح ذات الأثر في هذا التكاثر المأساوي لعلاماته الصادمة.
وهو ما نتبينه في أمكنة أخرى، كما في:
والحقٌّ
غالباً ما أشبّهك بقصيدة نادرة،
ما يجعلني أركن إلى غموض شبق ٍ كلما ألتقي بك ِعلى حافة الحقل، هنا يصحُّ
القول: حقل القمح أجملُ من أي وقت ٍ مضى ! تذكّري: على الحافة الجنوبية منه
تماماً مالت علينا السنابل بكثافة غريبة، لتستحيل إلى طيور باذيال مزركشة وأنا
أميل عليك برشاقة.ص 76
في هذا الوصف المركَّب، ثمة ما يدفع بنا إلى قراءة القصيدة إلى نهايتها. فإذا بها تنتهي ولا تنتهي، ولن تنتهي، وإن انتهت كتابة، حيث التالي جهة التداعيات والانطباعات هو ما يضفي عليها ما إذا كانت قصيدة أم لا، والشاعر في لعبته الشعرية يقول ما يبقي الوجود في انجراحه.
إنما في الوقت نفسه، يقول ما يستعصي على القول في تفسير محدد، ما يجعل روح الشاعر نفسها وقد أشكل عليها القول الفصل، لأنه ملبد بـ" الغيوم " متراوح بين ليل ونهار، وضمنهما، وفي قلق المعنى، واصطبار الموسوم، وما في هذا الاستبيان الكلامي من تمزق داخلي، حيث الوصف لا يبعث على الطمأنة، في معايشة تجمع بينه شاعراً وما يجري وصفه مشهدياً.
كما في "على رنة خلخالك يستيقظ العشب...!
في "مشهد" وهو يستدعي ما هو متداول في سياق علوم الاجتماع الحديثة في عالم اليوم والصاخب، بإشاراته العاصفة والمتحولة:
وأنت يا "بحيرة الحب" الصغيرة ،
أيتها البحيرة المنتشية بحفاوة صباحها
أيها العشب المكتنف بالندى، أيها العاشقان المتخثران في نشيد الليل،
ما من شيء قط، أيتها السموات الوحيدة في ضجرها، سوى هذا الافتتان،
فاتنٌ هذا المشهد المنحوت في سفوح الصمت، فاتنة هذه الأشجار التي تستستلمُ
للإغواء ، فاتن هذا الماء الراكن بين ردفي البحيرة. ص 97
ها نحن مجدداً مع "بحيرته" إنما مع معنى آخر، في وضعية أخرى، وفي مكاشفة أخرى، ورصيد اعتباري رمزي آخر، وقد اتسعت " الرؤيا " وبان القول في وضعية الممتحن والدال في الوقت نفسه على أن الوجع من نوع وجودي، لأن المسمى يُفتقَد إليه، وحيث نتلمس في المشهد ذاك كل ما يخص العوالم البرية، المائية، البرمائية، كما لو أنها اُستدعيت لتقول شهادتها وليس لأن تشارك الشاعر احتفاله بموعود ما، بمتعة لقاء، والإقامة في الزمان والمكان.
في القول الأخير وليس الأخير:
ما يلي المنعطفات الثلاثة، ما سيليه في القول والتكهنات، أي طي عنوان " نص الغلاف الأخير ":
في غيابك
الذي يتخثر كليلة مطعونة بعتمة آثمة،
لا علامة تغيث انتباهي، لا دروب تستنجد بعماي، كأنني لا أتقن النداء!
أناديك بقوة، ولكن ندائي يتعثر كحجر . ص 101
تكون هناك، ويكون هو " هنا " تكون الأنثى اللامحددة، اللاموصوفة بعلامات فارقة تحدد فيها جنسها ونوعها وحسبها ونسبها، فليس الشاعر في مشهد "جنائي" لينشر أوصافاً، أو مخبري ليسمّي ما هو عضوي، إنما ما يخرِج الموجود من صلابته، ومن حسيته، ومن إطاره المحدد، وهو في تأزماته، من وجهة نظر الشاعر، حيث " أنثاه " التي تُسمى وجوداً حياً، يُتلهَّف إليها، وتكون رهاناً، ومحك اختبار لوجود كامل، وما في ذلك من صدمة لوعي القائم، من اعتراف روحي صريح باستراتيجية الاسم الأنثوي واستثنائية المقام وبدعته، وتلك المسافة الفاصلة بين كونها وجوداً يشدد على تسميته والتفاعل معه، بدافع الرغبة في البقاء، في إمكان تحقيق المختلف والاستقرار أرضياً بعد ذلك، دون جدوى، لأن النداء يتعثر كحجر.
لتستمر المعاودة، ودون ذلك لا يكون الوجود جديراً بالتسمية، ولا الشعر جديراً بسماعه
أورد هنا ما قاله الكاتب الناقد والشاعر الفرنسي جان ميشيل مولبوا:
" أن تكون شاعراً اليوم ليس بالأمر السهل. نحن نعيش في عصر لا يعلق أهمية كبيرة على هذا الفن الذي كان في يوم من الأيام الأول من نوعه".
ذلك هو الرهان الأكبر، إنما ما يستحق الرهان عليه لتكون شاعراً، ولتقر بمكانة الشعر، وشهادته طبعاً، وما يستوجب التفاعل معه، لأن في قراءة الشعر عزاء الروح بالمطلق.
الشاعر خالد حسين أطلق نداءه الشعري، ولم يتعثر كحجر...
لقد نزف الشاعر كثيراً، وأضاء كثيراً...وما علينا إلا أن نرى ونسمع ونتذوق ما يغذّينا ويهدينا صراط الجمال الذي يرفع من شأننا، ويهذّب فينا فضيلة الإقامة في الحياة أكثر توازناً..!









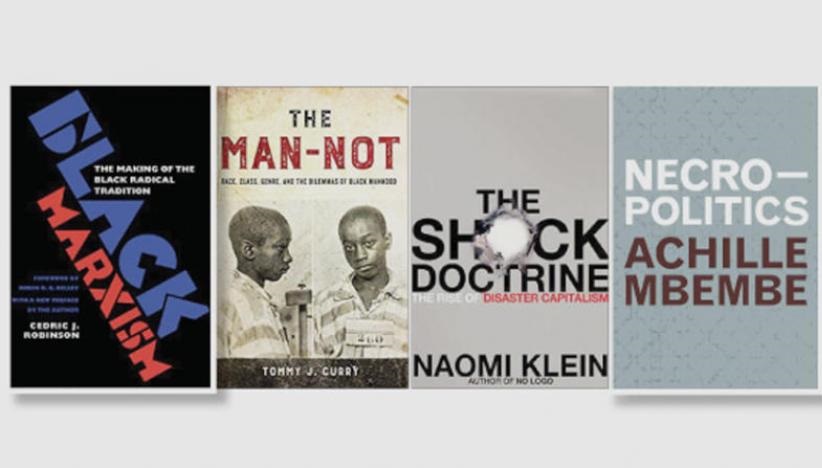
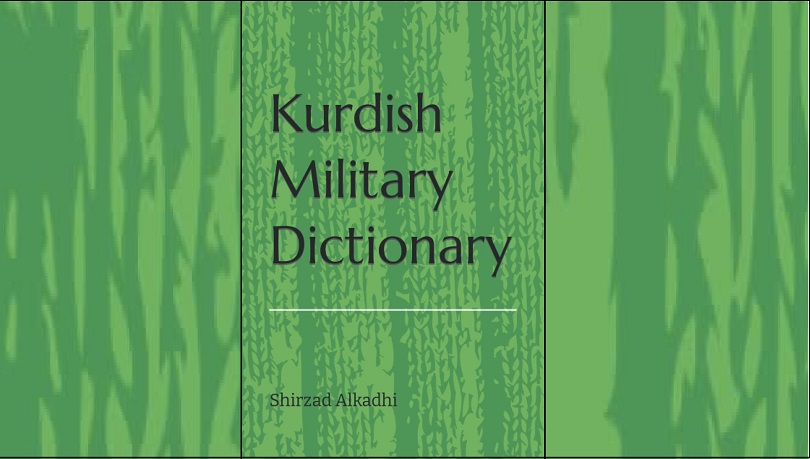
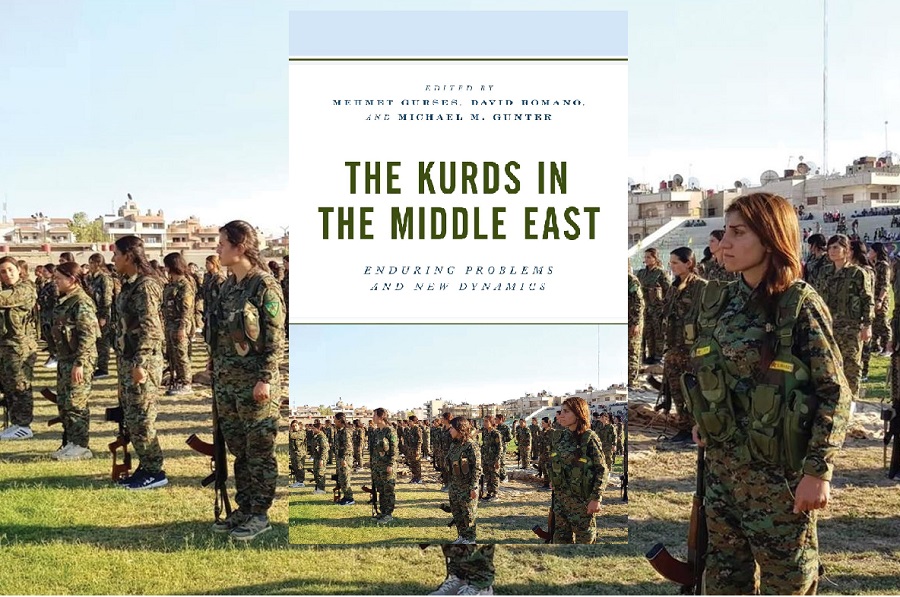




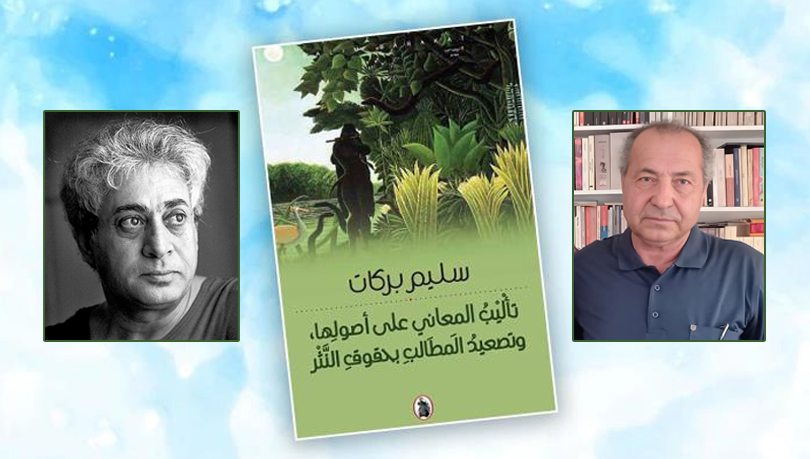

0 تعليقات