أخيرا، بات بوسعنا أن نعلن بثقة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب سيغادر البيت الأبيض، وإن كان على مضض، في العشرين من يناير/كانون الثاني. مع انتهاء سنواته الأربع في المنصب، ليس من السابق للأوان أن نطرح السؤال حول الكيفية التي سيذكره بها التاريخ.
سيحكم التاريخ على ترمب باعتباره رئيسا مهما للولايات المتحدة، لأنه ترك أميركا وقد تغيرت هي والعالم إلى حد كبير. كما سَـيُـنـظَـر إليه على أنه واحد من أسوأ الرؤساء، إن لم يكن الأسوأ على الإطلاق.
صحيح أن ترمب أنجز بعض الأمور المفيدة. فعلى المستوى المحلي، دفع بسياسات يبدو أنها ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي ــ خفض معدل ضريبة الشركات الذي كان مرتفعا للغاية؛ وتخفيف بعض الضوابط التنظيمية الـمُـرهِقة. وفي عالَـم السياسة الخارجية، يستحق ترمب أن ننسب إليه الفضل في تحريك سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، المتزايدة القوة والـقَـمع والعدوانية، في اتجاه أكثر رصانة وانتقادا. كما كان محقا في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، خاصة وأن جزءا من ذلك البلد واقع تحت الاحتلال الروسي.
كان التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك وكندا، ثم إقناع الكونجرس بالموافقة عليها، إنجازا كبيرا، حتى وإن كان التحسن الذي طرأ على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) متواضعا، ورغم أن أجزاء مهمة من الاتفاقية الجديدة كانت مأخوذة من نص الشراكة الأكبر كثيرا عبر المحيط الهادئ والتي رفضها ترمب بحماقة. كما لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في تسهيل عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب، على الرغم من فشلها في إحراز أي تقدم بشأن القضية الفلسطينية.
بيد أن هذه الإنجازات وأي إنجاز غيرها يتضاءل أمام الأخطاء التي ارتكبها ترمب. وهنا تبرز ثلاثة إخفاقات بشكل خاص. يتمثل الأول في الضرر الذي ألحقه بالديمقراطية الأميركية. كانت أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما قام حشد من الغوغاء من أنصار ترمب بمحاصرة واحتلال مبنى الكونجرس الأميركي، ذروة الجهود التي بذلها الرئيس لشيطنة الإعلام، وانتهاك الأعراف الراسخة، والترويج للأكاذيب، والتشكيك في سلطة المحاكم، ورفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجتازت كل اختبار جدي لشرعيتها.
كان تحريض الناس وحضهم على ممارسة العنف وأنشطة غير قانونية بمثابة القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير. من المؤكد أن ليس كل اللوم هنا يقع على ترمب. فلم يُـجـبِـر أحد هذا العدد الكبير من شاغلي المناصب من الجمهوريين على الانصياع له في السعي إلى تقويض شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. ولا شك أن أولئك الذين عملوا على تمكين ترمب من خلال دعمهم المالي والسياسي يتحملون المسؤولية بالمشاركة عن هجومه المتواصل على القيود التي تشكل أهمية بالغة لعمل أي نظام ديمقراطي. ومع ذلك فإن ما يميز واقعة الشعبوية الأميركية هذه عن غيرها من الوقائع السابقة هو أنها كانت مُـدَبَّـرة ومصممة في المكتب البيضاوي وليس من الخارج.
تشكل جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) القضية الثانية. كانت فاشية فيروس كورونا وانتشارها اللاحق نتيجة لإخفاق من جانب الصين، لكن استجابة ترمب الحمقاء وغير الوافية هي ما يفسر السبب وراء وفاة 400 ألف أميركي بسبب هذا المرض بحلول الوقت الذي يترك فيه منصبه. كما تسببت الاستجابة الأميركية المعيبة المنقوصة في اختفاء ملايين الوظائف والشركات (بعضها بشكل دائم)، وتخلف ملايين الطلاب عن الركب، وفقدان الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم احترامها لأميركا.
كان بوسع إدارة ترمب، ومن واجبها، أن تفعل الكثير في التعامل مع فيروس كورونا. ورغم أنها تستحق الثناء للدور الذي لعبته في التعجيل بتطوير لقاحات كوفيد-19، فإن هذا الإنجاز تقوض جزئيا بسبب الفشل في الترتيب لتسليمه إلى الناس بكفاءة. كما فشلت الإدارة في تقديم رسائل متسقة حول الحاجة إلى أقنعة الوجه، ولم تضمن حصول العاملين الطبيين على معدات الوقاية الكافية ولم توفر الدعم الفيدرالي الأساسي لتطوير اختبارات فَـعّـالة.
يؤكد التباين مع الاستجابات الناجحة نسبيا في تايوان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وألمانيا، وفيتنام، والصين أن الفاشية الفيروسية ما كان ينبغي لها أن تتحول إلى جائحة، وبكل تأكيد ليس على النطاق المشهود في الولايات المتحدة. من عجيب المفارقات هنا أن ترمب كان يخشى على ما يبدو أن يؤدي إعطاء الأولوية لمحاربة كوفيد-19 إلى إضعاف الاقتصاد وتقويض فرص إعادة انتخابه، في حين أن إخفاقه في الارتقاء إلى مستوى التحدي هو الذي ربما قضى عليه في حقيقة الأمر.
كان الفشل الثالث المميز لإرث ترمب متمثلا في السياسة الخارجية التي قوضت مكانة أميركا في العالم. ترجع هذه النتيجة جزئيا إلى السببين الموضحين أعلاه: اعتدائه على الديمقراطية وفشله في التعامل مع جائحة كوفيد-19.
لكن سياسة ترمب الخارجية فشلت أيضا لأسباب مرتبطة بالسياسة الخارجية في حد ذاتها. فقد أضافت كوريا الشمالية إلى مخزونها النووي وصنعت المزيد من الصواريخ الأفضل على الرغم من دبلوماسية ترمب الشخصية مع كيم جونج أون. أما إيران فقد قلصت الوقت الذي تحتاجه لإنتاج أسلحة نووية بعد أن انسحبت إدارة ترمب من جانب واحد من اتفاق 2015 النووي مع إيران (خطة العمل المشتركة الشاملة). وأصبحت دكتاتورية فنزويلا أشد رسوخا، وزادت كل من روسيا وسوريا وإيران من نفوذها في الشرق الأوسط بعد أن سحبت أميركا قواتها ودعمها للشركاء المحليين.
على نطاق أوسع، أصبح انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات والمؤسسات الدولية السمة المميزة لسياسة ترمب الخارجية، كما فعل انتقاده لحلفاء أميركا الأوروبيين والآسيويين، وعلاقاته الدافئة مع قادة مستبدين، وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت النتيجة النهائية تقليص نفوذ الولايات المتحدة على المسرح العالمي.
وَرَثَ ترمب مجموعة من العلاقات، والتحالفات، والمؤسسات، التي نجحت على الرغم من أوجه القصور التي تعيبها في خلق سياق حيث جرى تجنب صراع القوى العظمى، وتوسعت الديمقراطية، وتحسنت الثروة ومستويات المعيشة، طوال خمسة وسبعين عاما. باحتضانه مزيجا من قومية "أميركا أولا"، والقرارات الأحادية، والانعزالية، بذل ترمب قصارى جهده لتعطيل العديد من هذه العلاقات والترتيبات دون أن يضع في محلها أي بديل أفضل.
سيكون من الصعب ــ إن لم يكن من المستحيل ــ إصلاح هذا الضرر في أي وقت قريب. صحيح أن ترمب لن يكون رئيسا بعد الآن، لكنه سيظل مؤثرا في الحزب الجمهوري وأميركا. بينما كان العالم يعيش بالفعل حالة من الفوضى المتنامية، وفي حين كان نفوذ الولايات المتحدة في انحسار واضح، عمل ترمب على تسريع هاذين الاتجاهين بشكل كبير. المحصلة النهائية هنا هي أنه يسلم بلده والعالم أجمع في حالة أسوأ كثيرا مما ورثه. هذا هو إرثه المفجع الكئيب.
المصدر: بروجيكت سنديكيت
ترجمة: مايسة كامل



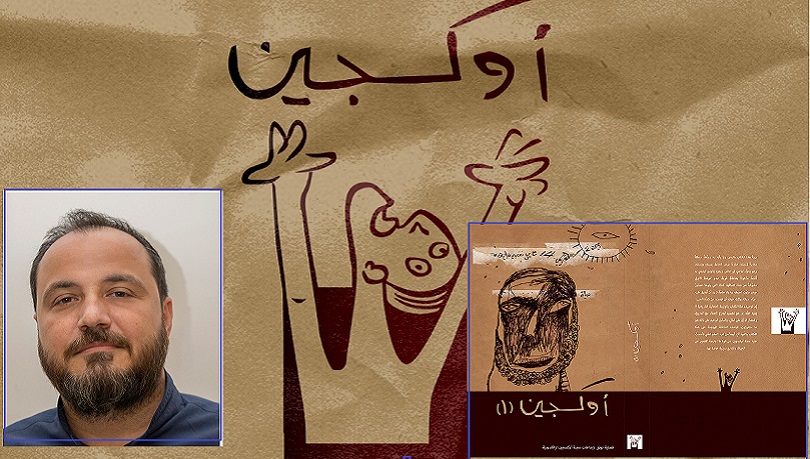
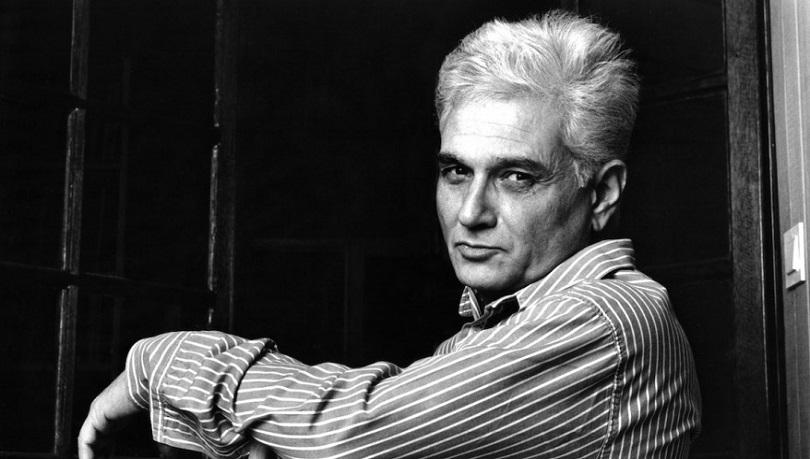










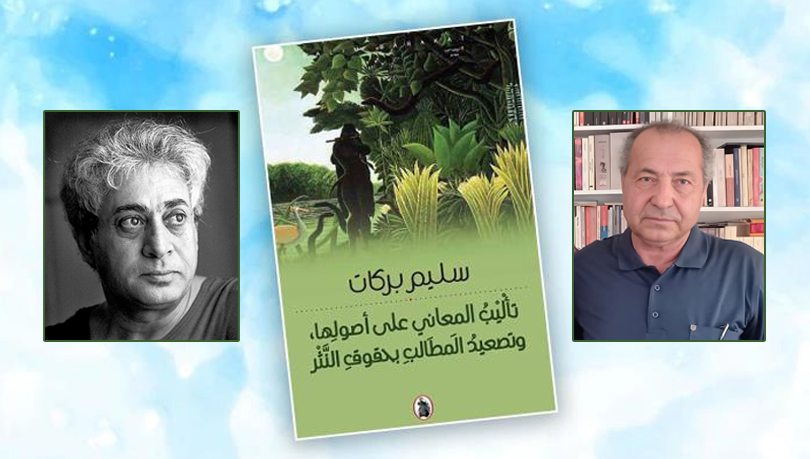

0 تعليقات