خيانة الاسم
من المفارقات الكبرى لصيغة " السيرة الشخصية/ الذاتية " أن الذي يجري العمل بموجبه، ويعوَّل عليه كتابةً، هو أن ما يخص معنى " السيرة ": من سار، سيرورة، يشكّل قلباً للصورة، وتحويلاً للنظر إلى ما يعطّل العمل بهذا المأخوذ به ظاهراً. ثمة من يسير، من يُرى، من يعايَن، من هو ظاهر، من يمكن تعقّبه...إلخ، سوى أن السيرة، ما أن تعلِن عن نفسها، حتى تطوّب نفسها هذه، خلاف ما يمكن توقّعه جهة المعنى، فما يسير، ليس ما سار، إنما ما يحيل الأفقي إلى العمودي. ما يتخذ هيئة الجذور المشرشة في الأعماق، ووحده المعني بأمرها قادر على إبراز الصورة المتجذرة، وتبعاً لذائقة نفسية، لمقدرة المواجهة مع الذات، وكيفية تحويل الكامن إلى ظاهن، أو ما كان له أصل ما، إن جاز التعبير، يضاء ظاهراً، عبر عملية مسح أركيولوجية، وحده المعرَّف بها يكون مصدر القول، أو المرجع في بنيته، وما يمكن أن يثار من تساؤلات، أو مساءلات جهة الوارد سيرةً، والتي يكون لها اعتبار يتناسب والاسم الحامل لها، فالمواقع تظهِر تباينات السيَر، كما هو معروف.
سوى أن الأهم، هو ما يمكن قوله في أن السيرة ترسم خطاً فاصلاً بين ما هو مضاء، وما هو معتَم عليه، وليكون للغة دورها في فعل الإضاءة، واعتماد إرادة مكاشفة لحقيقة تخص المعني، وما في ذلك من فضول لدى القارىء، ومن خلال طبيعة معرفته لمن يقرأ سيرته. فالبعد والقرب، لاعبان لا يمكن تجاهل أهميتهما، في تحديد نوعية العلاقة بين كاتب السيرة وقارئها، وتلك بداهة، فمن يعرف شخصاً ما" أن يكون كاتباً هنا، كمثال حي"حين يقرأ سيرته، يقيم علاقة تناظر أو ربط بين ما يقرأ وما يعرف عنه، وهو قريب منه، أما البعيد، فطبيعة الوارد في السيرة ستشغله .
ثمة سرّ، هو الذي يحيل السيرة ككلمة إليه، لا بل إن السيرة نفسها في قرارة نفسها، تدرك جيداً إن كاشفْنا حقيقتها، هي التي تراهن على ما تقدم: كيف تتخلى عن " حرفين " فيها، وتستبقي حرفين بالمقابل " سر " لتكون قادرة على متابعة مهمة التعبير عن حياة تفرض حضورها بمقدار ما يكون التعبير عن السر الموسوم، ما يكون السر نافذاً بأثره المتعوي، قائماً، ولعبة الانتقال من كون الكاتب عارضاً إلى اعتباره معروضاً، وما يجعل المعروض فاعلاً في مساءلة الكاتب عما سطَّره.
أي ما كان للفن من بروز في الكتابة، وجانب التمايز، وما يتولاه خارج المألوف، حيث ( إن الفن لا يتولد عن الهدوء والطمأنينة، مهما يكثر نصيب الفنان من الشعور أحياناً بالهدوء في عملية الكتابة، إنه ينبع من التوتر والعاطفة، ومن حالة عدم التوازن تعتري الفنان..)، كما يقول " ليون إدل " في " فن السيرة الأدبية. ص 152 "، ولا بد أن كاتب السيرة هو فنان، وكتابة الكلمات تتخذ صيغة التلوين بالكلمات، والرسم المأخوذ به لحياة لا يحاط بها، ليكون للفن بُعده العميق، وأهلاً لينظر في هذا الموقَّع عليه سيرة، وما يؤخَذ منها ليس المتعة حصراً، إنما ما يثري الروح .
تلك مغامرة بين الكاتب وما يكونه في قرارة نفسه، وما يكون للقارىء من صورة متشكلة، قارىء يترقب سيرته منشورة ، وهو في أفق آتيه، بحثاً عن سر، وكيف يكون هذا الآخر محمولاً به.
وهنا، تكون مغامرة الكتابة السيرية، مقرّرة في نموذج، توقفت عندها، في مسار التقاط السر، الذي انشغل بأمره حامله، تصريحاً، كما هو المسطور لديه، وخاصية المصرَّح به، أي الكاتب والشاعر السوري محمد المطرود. وعلي أن أكون أكثر دقة، وتجاوباً مع المذكور في متن قوله: نصف الكردي ونصف العربي، أو بالعكس: كرديّ الأم، عربي الأب، وفعل ذلك في سيرته، والتي تحمل اسماً لا أظنه بسيطاً، عادياً، وهو " سلالة العجاج- المؤسسة العربية، بيروت، ط1، 2022 " العنوان الصادم واللافت بفحواه !
هذا العنوان يؤخَذ بما يُعطى من دلالة تمضي بقارئه إلى مشهد العجاج هذا الذي يكون غباراً وليس بغبار، وهو يتطاير في الهواء وفعل كل منهما بالآخر، وهو " يعكّر " صفو الهواء، وهو يقلق أهل المكان، وله حالات أو هيئات قوة أو ضعفاً، كما لو أن العجاج تلخيص مكثف لواضعه.
ولا بد من الإضافة التي تشكل تقليماً للعنوان ذاته، جهة التحديد، حيث نقرأ طيَّه: وَسْم البدو وأنا/ النهايات والساعات الإضافية، ففي ذلك ما يحيل العنوان إلى كاتبه ومن يكون، أو ما يجب التفكير في موقعه ونسبه، ما يشغل الكاتب في " وسم البدو " وأناه التي يعرَف بها عميقاً، وما يترتب على ذلك حيث علامة/ تعني أكثر من كونها جداراً مائلاً، أي ما يُلحَق بالنهايات، ويعطي للساعات الإضافية في بُعدها الزمني أهلية اعتبار، تشير إلى أن هناك ما يستوجب التوقف عنده.
أي ما يخرج البدوي عن نطاق السيطرة، كونه الراسم لعالم يعنيه أبعد مما هو حضري !
علينا في الحالة هذه، أن ننظر في اتجاهين: ما تقوله العبارة، وما ترمي إلى قوله العبارة. وأن ننظر في الجانبين: ما هو مرئي في هذه الجهة أو تلك، وما هو طي المرئي ودلالته .
وسياسة القراءة هذه، تتماشى مع خاصية السيرة، بمقدار ما تستجيب لمجمل ما هو مسطور ومأخوذ به في السيرة حيث الظاهر والباطن يتناوبان على تقاسم العبارة وطبيعتها، الصورة وهيئتها، المفردة الواحدة، والموقع العائد إليها في الجملة، وفي لعبة الثنائيات ما يحفّز على القراءة، وما يوجب الحذر، بغية عدم المضي بالقول إلى مستوى التقويل، وما في ذلك من قسر المبنى على معنى مفارق له.
الثنائية المعذبة
في فقرة تحمل عنوان" محطة القامشلي " نقرأ التالي:
أحب القامشلي، كما أحب امرأة مكتنزة، اسمها عبطة، اسم عربي فصيح، تتلبسه امرأة كردية، عشقت قبل خمسين عاماً، بدوياً، وصارت جزءاً من تاريخ البداوة في الجزيرة السورية، المرأة أمي، والبدوي أبي، ولحظة اشتهاء عالية انجبا ولداً حنطياً، يجمع في سحنته، البرونز بالنحاس الخفيف، ويتحدث بلغتين، ومع الحرب الجديدة في البلد، ينشطر قلبه إلى نصفين، إلى حياتين، حياة تنتمي إلى الزمن، وحياة أخرى إلى اللاجدوى. ص 169 .
هذه الثنائية التي أفصح عنها المطرود لا تؤخذ على عماها، إنما ما هو مودَع في مداها، إن جاز التعبير. ثنائية تكاد ترسم تاريخ مجتمع بكامله، وصيرورة حياة بكاملها بالمقابل. إذ بين الحديث إلى والدين مختلفين جهة الأرومة، أو الجنس، وهو يجمع بينهما، ولغتين مذكورتين، هناك تاريخ آخر يمتد إلى الداخل، جهة تأثير ذلك على بنية العلاقات الاجتماعية، جهة التوترات القائمة، وفي مقدور القارىء المنتمي إلى المنطقة أن يدرك ذلك الألم المرفق بالكتابة، ألم الربط بين عالمين لا يخفيان توتراتهما، في بلد لا يخفي فعل تأثير علاقات كهذه في سيرورةالعلاقات الاجتماعية .
الاكتناز اقتصاد الوفرة، أبعد مما هو شبقي الذي ينبني بدوره على ما هو متوخى حيوياً وبمتعة!
وما يعمّق مأساة الاعتراف، وصدمة الشهادة ودقتها، هو القائم على نوع من التراجيكوميدي، كما لو أن الكاتب، ولو بينه وبين نفسه، يسخر مما يجري، ويتهكم عليه، رغم أن عملية مصاهرة كهذه تغني العلاقات فيما لو كانت الأرضية المجتمعية متماسكة. وهو" الكاتب " ينطلق من الداخل، جهة الزواج المذكور، إلى ما يعنيه في الهيئة، وما في ذلك من وضوح صارخ .
أحسب أن الثنائية هذه، وهي في جمعها العالي مسافة ورحابة رؤية شاعرية تحديداً، مشتهاة من لدنه، ليس هوساً أو جرّاء عصاب يتواسى بها، وهو منكفىء على نفسه، بالعكس من ذلك، فما هو سيال بقلمه، ومستقدم من المجهول، المغيَّب، المعتَّم عليه، واللامسمى، يتخذ طريقه إلى الصريح الواضح كثيراً، والمعلوم كثيراً، والمضاء بكشوفاته المحيطية وبطابعه الأنثروبولوجي. وحين أعطي لمفردة " الأنثروبولوجيا " مكانة، وأنا أتحدث عن سيرة كاتب له مجتمعه، وتاريخه الشخصي والاعتباري، بصورة ما أو بأخرى، فإنما انطلاقاً من كون النص المحرَّر من جهته، ينكوي على وفرة معلوماتية محتسبة وتسهم كثيراً في مكاشفة جملة العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين أهل المكان، وكيف ينظرون إلى بعضهم بعضاً، وطبيعة العلاقات هذه، وآلية العمل بها.
لعبة الثنائية تكاد تسم " سلالة العجاج " من ألفها إلى يائها، وما بينهما من علاقات مقدَّرة، وما في كل متابعة، طي كل عنوان فرعي، من ومضة جمالية تشي بمكنون ما. بدءاً من مفهوم " العجاج" بالذات. هنا ثمة الهواء، وثمة الغبار الناعم وربما أكثر، تبعاً لقوة الريح، وكأني بالكاتب بدءاً من عنوان سيرته، يحيل القارىء إلى ما يعنيه في الصميم، إلى قلق يعيشه جرّاء توتر مجتمعي، أو في مجتمع لا يخفي لاسويته، وما في ذلك من خلل صدعي في أصله، لاسوية تعيق بناء المجتمع الذي يراهن على قيمة الإنسان وليس نسبه، وهو ما يمكن تبيّنه في أصل المطروح.
المطرود: مطارد نفسه، وطريدها، إن اعتمدنا على الاسم/ اللقب، النسبة، تعبيراً عن حالة تستغرق الكتاب إجمالاً، وما في ذلك من مأثرة علاقات القربى بين كونه الساعي إلى الهدوء والسكينة، والمتخوف من نقيضه، كما لو أنه يعيد سيرة ملتقطة من خلال عبارات عدة، ويتمثلها مكرها، كون الواقع هو الذي يستدعي هذا الماضي ويذيبه في بنية نصه، أي جده البعيد( كان اسمي بلاحقته كاسم مفعول ليس كنية، بل ينحدر من واقعة متعلقة بجد بعيد وزواجه من امرأة لم يرق للقبيلة شأنها وحسبها، فنفوه وصار لاجئاً في مضارب العربان الأخرى، ويتداول الاسم تلميحاً كلما ضاق به الغرباء وتصريحاً في المشاجرات ولم يكن كحالنا اليوم ليسمى الغريب، كان يسمى المطرود أشبه بالبلّاش في سيرة هدّار ترف، بفارق أن في حال الجد أكتفي بالنفي من دون القتل، انجب المطرود أولاداً وبناتاً، ولم يتوقف عن الطراد والفروسية وغزو القبائل . ص 152 ).
ولعل الذي يُسمَّى هنا، يضعنا في مواجهة كاتب السيرة بالذات: ثمة امرأة فاصلة في إحداثية عالقة في فضاء الزمان والمكان، وقيم متداولة تتلون بمثل هذه العلاقات، ومغامرة الأب الذي يخرج عن " قانون " القبيلة، ويخلص لقانون الطبيعة المضياف، ويتابع مسيرته الحياتية مع زوجته، وهنا يتولى الكاتب تأريخ الواقعة، ومن منظور آخر، كما لو أن كتابته تعرية لعلاقات كهذه، ومحاولة الغزو المستمر لما هو قائم، لأن الكتابة تنفتح على ذاكرة منجرحة ومنقسمة على نفسها، وهي في مسعاها تروم ذاكرة على مقياسها، ذاكرة تؤمم غداً يكون تاريخاً مقروءاً ضداً على ذاكرة مؤلمة.
للثنائية ضريبتها، وفي مجتمع يأخذ بها قهراً، والكاتب يأخذ بها سبراً ومكاشفة خلفية القهر بلغته.
منذ البداية يكون القلق شاهداً عليه وهو يتشرب لغتَه( تركت باباً ( للأصدقاء) إذا ما جاعوا، ولم يجدوا كلاماً يأكلونه، يفضي بهم إلى حديقتي الخلفية، هناك سيجدون الحيوانات الأليفة والشرسة معاً، وسيكون نبع صاف، سيغص بمائه الواشون والنمامون، فلا أريدهم نصف عدو ولا نصف صديق، ولا وجهاً مبتسماً، ولا سكّيناً تلمع خلف ظهري، كلما اقتضت حاجتهم.ص 7 ).
لا يخفي الكاتب، كما هو مقروء في سطوره هذا التصنيف، وما فيه من ائتلاف قواه، تجنباً لأي صدام جانبي، وما في هذا التصريح الوصفي من إضاءة مشهدية لمجتمع لا يؤمَن جانبه كذلك .
فالبلد في مجموعة خرائب والقيّمون عليه باعثو خراب، والذاكرة القريبة تدلي بدلوها، وهي تفصح عما كان يجري تمهيداً متوقعاً للدفع بالبلد إلى الخراب، إلى ما هو كارثي ، كان وراء خروجه .
وفي الوقت نفسه، فإنه حين يحيل العالم الخارجي إليه، فإنه إشهار بحقيقة تعنيه ويسمّيها لقارئه، حيث الماضي ليس مرغوباً فيه، بالعكس، إنه في " مشرحته " النقدية، وهو نازلٌ فيها تعريةً لأن فيه ما يبعث على النفور، وتسوية، حباً بالمغاير الذي يبدو أنه بقي في حكْم المؤجَّل حتى ما بعد الكلمة الأخيرة في سيرته، وما يخص " التتمة " في حكم المجهول، وفي ضم الحقيقة إليه ما يقرّبنا من تلك المكابدة التي تقوم على حدين غير متناغمين ثنائياً، وللغة أن تقر بواقعة مرصودة( أريد الحقيقة عارية غير مجزأة، أو مختفية خلف الأكمة، أكره الأكمة، ولو لي قدرة خارقة في اللغة، سأستأصلها من قاموس يأخذ بأواخر الكلمات، وليس بأوائلها، لأن أواخر أيضاً تحيلني من حيث لا أحتسب إلى التفكير بكلمة مرادفة: الذيل، ودائماً إن لم يكن من فائدة من التابع، فلا فائدة أيضاً . ) .
وما يعمّق في بنية الإهداء تالياً( أهدي إليهم المعنى أيضاً لينهشوا لحمه، وأهدي إليهم قدرتي على ادّعاء الحماقة، بينما أنا كائن ذكي، أتعثر بالحياة أكثر من مرتين . ص 7 ).
هكذا تبتلي الجغرافية نفسها بكتابته، ونوعيتها، لأنها شاغلة مأساة ومشغلها في الوقت نفسه، وثمة تاريخ مقروء بصيغ شتى يؤرشف لهذه المأساة التي تستغرق البلاد مشرقاً ومغرباً، وفي الجوار.
وفي الحالة هذه، وهي جلية العنف، لو أن قارئاً للمسطور هنا ومعاينة أبعاده، ويأخذ بلغة فرويد، لصرخ عالياً: يا للسادية المصرَّح بها ! لا بد أن وراء هذه الكلمات ما ينبىء بأمر آخر، وهو المتمثل في العنف المأخوذ به واقعاً، وهو المعايَن من لدنه.
فلو أن إحصاء تم بصدد معرفة عدد الكلمات التي تنمّ عن عنف موجود، وبصور مختلفة، لأظهر واقعاً يتنفسه كاتب السيرة، ومن خلال أسلوبه في الكتابة وفي تسمية عالمه، لا يمرَّر بسهولة، وخاصة في مفردة مثل " نهش اللحم "، ولا بد أن واقعة الثنائية السالفة تشهد على مرارة تحوز كل شيء إليها، وهي ترمي بثقلها على ذاكرة الكاتب القريبة، وما في ذلك من تشهير بالموصوف.
نحو اقتصاد اللغة
في قراءة السيرة الذاتية، أو ما يُدخلها في ظلها، لا يخفي الكاتب، ومن خلال أسلوب الكاتب، وما يعتمل داخلها من مشاعر وأحاسيس وهواجس، وتوترات تلوّن اللغة، يسهل التعرف على ما يُسمّى بـ " اقتصاد اللغة "، وهنا لا أعتمد على معيار حسابي" طولاً وعرضاً وعمقاً " وإنما على ما يتوقف على النص المقروء، وكيف يعرَف بنفسه من خلال الكلمات كماً وكيفاً.
هل من تكثيف للصورة؟ تبعاً لأي معيار تذوقي، يسطّر الكاتب كلماته، ويمضي بها من عبارة إلى أخرى، أو من حالة إلى أخرى، حيث يبرز نسيج سيرته متداخلاً مع ما هو روائي أو مرفق بخاصيته الروائية" هدّار وترَف " ومأساة العلاقة الاجتماعية في إهابها الجنساني؟
في عملية التوصيف تتكلم اللغة، أو يتكلم كلام المتكلّم، الذي يكون الكاتب، وما يتكلمه ينعطف عليه، كما أنه يقدّم تعريفاً بطريقته في الكلام، وأزعم هنا، أن بنية القول المسرود لديه تقوم على ميكانيزم الذاكرة المنجرحة تحت وطأة المعيش اليومي، وهو مجتمعي، ذاكرة لا تنفصل عن بعدها البيئي أو المحيطي العام، ومن الطبيعي أن المؤلم في الذات الواعية، يمارس توجيهاً للكتابة بحيث تستجيب لخاصية الألم، وما من شأنه رفع سوية الألم هذا إلى شاهد إثبات على لاسوية مجتمع بالكامل.
ثمة التوصيف، وثم الشرح، وما يقوم على التوصيف يعزَى إلى هذه المعاناة العميقة. كما لاحظنا منذ البداية، وليس من أفق رؤية يزّكي واقعة منتظرة لتحل محل واقعة مشهود لها بالتوتر.
لاحظوا، أو كما ألاحظ أنا( أحاول قص سيرتي من شجرة توشك على الموت وإن واقفة وقص الحكاية من منظوري للأشياء ووفق قناعاتي لا وفق جدلية تشكّل الكون وانفجارات الكتابة. ص 11 ). في " الموت " ما يمارس مسحاً للمجتمع وهو متشظ، أو معنّى، وفي أصل الشجرة الدالة على الحياة، ما يعرَف بذلك . وما يصله بانفجارات الكتابة، كما لو أنه بأسلوبه هذا يضيء مسار حياته التي يرتضيها لنفسه، على النقيض مما عرِف به، أو ما كان يرفضه .
المطرود، يتعامل مع عالمه، كما لو أنه مجرد من أسمائه، حيث يسربله بالصفات التي يراها قابلة للتطبيق، وليس من محظور في بنية التصرف هنا، فهو الخصم والحكم/ ولهذا تكون الصورة واضحة بالمقابل، أي ما يبقيه في أفق رؤية القارىء. لكنه في الوقت الذي يقول( ما تعلَّمته منذ طفولتي أن لكل أحد تاريخه الشخصي. ص 20 )، نراه في مكان آخر يقول( ليتني أستطيع أنا المتناهب في شخصين أن أفعل ما فعله البدوي، فأرمي عن كاهلي ما أراه حملاً ثقيلاً، أو غوراً في جب عميق، حيث يمر بي السيّارة فلا يسمعون ندائي، ولا يجدون قميصاً ملطخاً من آثار ذئب المجاز . ص 23 ). فإنه يصل أثره هنا، وهو في هجنته، حيق يلتقي النثري بالشعري، بما سبق أن ظهر به شاعراً، في ( سيرة بئر- 2005)، وفي ( ما يقوله الولد الهاذي- 2009 )، وهو ما يستوقف قارئه به، توقيفاً لزمن كان، وهو مأهول بمن يمكن أن توجَّه إليهم سبابة الاتهام، وخاصية " البئر " وحكاية الأخوة الذين غدروا بأخيهم " يوسف " وما يوسّع في نطاق الحكاية هذه .
وهو ما يدفع به إلى اتخاذ القرار الذي يخرِجه عما هو أهلي إلى البرّي كرهاً للسائد والمأخوذ به، ومن يتمثله، هناك ما يستحق النظر فيه، وهو في مشهد لافت( لا أمتدح الكلاب، ولي رأي متطرف يخص وفاءها، ولهذا أميل للذئب، فانا أعده كائناً نبيلاً، لا يؤهَّل، لفرط شجاعته على عكس الكلب الذي يكون بحاجة إلى صاحب، يهز ذيله بالقرب منه نذللاً، وهو في كل الأحوال يتحصّل زاده من هذه التبعية . ص 97 ) .
ذلك من شأنه التفريق بين تصورين، وهما من ثنائياته البارزة، وتحديداً بالنسبة للذئب المراهَن عليه طبعاً، وما يقرّبنا من الموقع الذي ينطلق منه، أو عبْره تكون رؤيته للعالم، أي ما يكونه هو نفسه ذلك الذئب الذي يتحدى كل عرْف أو ما يشبه القانون لترويضه، وسيرته في جوهرها تتمحور حول إما أن يكون التابع، وما في ذلك من خنوع، أو يكون المتحرر المأخوذ بشخصيته وعنفوانها، حيث يمثُل الذئب أمام ناظرينا( يا لذئب البوادي/ السهوب، للألماني هيرمان هيسه )، ولا بد أن تسليط الضوء على حركية الكلب، يدخل في نطاق المأثور الانفعالي النفسي، وهو يشرح سلوك الكلب، رغم أن أياً كان، يدرك مثل هذه الحركة الكلبية، سوى أن مضيّ الكاتب إلى التذكير بما تقدّم يعزّز بؤرة التوتر، لكأن تسمية ما جرى، يعمّق الأثرة، ويُصادَق على دقتها أكثر .
نعم، الكاتب ذئبي، في هيئة ذئب، وربما يكون طوطمه ذئباً، إضاءة مستمرة لموقعه في العالم، ولأنه شاعر في الأصل، ولأن السيرة هي الشهادة الحية المترجمة لروحه في الصميم كان هذا الاستئثار بجملة الكلمات التي تستبقي الذئب في الواجهة، كما في ( في مديح الذئب/ ذئبي: أعدو مثل ذئب سعيد، أستشرف سهلاً خلف التلول، رأيت نسوة بثياب سود، يلممن كعوب الزروع النادر. ص 25 ).
الربط بين الذئب والسعادة فعل إسقاط لصفة مؤنسنة، والجري في السهول خيار الحرية التي ينشدها، وترْك عالم البشر، وممن صدم بهم في الخلف .
وما يعمّق طابع الصدمة لديه، في العنف التصويري:
( سأشرب المياه العكرة وبول الحيوانات ورغوة السراب، وسأدخر مائي العذب لأحد عزيز نادر خانته أيامه، وضاع في متاهة السوريين. ص 49 ).
وفيما بعد، في " أنا والقرين "( كما لو أنني آخرين سواي، أراني أشباحاً في مرآة مكسورة يقضون الوقت في قضم أصابعهم ، أصابعهم التي طالت في الندم. ص 55 ).
وثمة ما يستدعي التوقف جهة الإحالة على الئذب ونوعيته:
( منذ أن عشت قصة الجنوب، تقاطرت صوبي ذئاب كثيرة وثعالب وخرفان. ص 61 ). هنا لا يعود الذئب من النوع الموصوف آنفاً، مما يشطر في مفهوم الاسم، وتبعاته النفسية، وما يوسّع مفهوم الاسم، بصدد الذئب، في التقريب والتبعيد بالمقابل .
القلق المستمر
ليس من ناظم مكاني محدد، يمكن النظر فيه، بوصفه كلاً متكاملاً، إنما هو انتثار المكان، لأن شخصية الكاتب في السيرة ليست مقدَّمة في تلك اللحمة التي تجيز لنفسها إملاء صفة واحدة على من يهمه أمرها، أو أخْذها من زاوية محددة، لأن لغة السيرة وهي في جمالياتها الوصفية اللافتة، تنطوي على مأساة تحدِث إرباكاً للمعنى، بمقدار ما تضيء صدوعاً في النص الذي لا يؤخَذ به سوياً في مفهومه، كوحدة، وإنما كانفجار تضاريسي، إن تجاوبنا مع منطوقه جغرافياً، وما في هذا التشظي من تأكيد، وبأكثر من معنى على عمق المأساوي المعبَّر به عنه، ليس من ناحية كون الكاتب أخفق في التعريف بما تكون عليه حياته، وإنما ما يخص مفهوم مجتمعه الذي يظهر هارباً منه، مجتمع اللاحرية، مجتمع الإخفاقات الكبرى. إن مفهوم " الهزيمة " انتصاري له هنا.
ولهذا فهو حين يقول تحت عنوان " طوبى لأصدقائي نجوا من حياتي القليلة " وهو عنوان فقرة صغيرة في نهاية قسم" القامسلي حلب وبالعكس: ( طوبى لهذه السيرة التي أنهيها بما يجب أن أبدأ به، لعل هذه الطواف حول الحرب والمدن، يلف بخيط الدلالة، هذا المقترح السيروري بخيط ناظم، فلا يتبين قارئي عثراتي وهناتي، ويذهب مع ما تركت قصة وغصة. ص 176) ، لعله بذلك يؤكد جانب النعي الكارثي، أو الحداد الذي يستغرق كامل المساحة الجغرافية للبلد.
وهو ما نتبينه في وصفه المتعلق بما يشاهده حين يدخل البلد( تأخذني حافلة بيضاء من القامشلي إلى معبر تل أبيض، طيلة الطريق تتجاوز الرايات: حماة الوطن، حماة الشعب، نصرة الأمة، أحرار البلاد، وسأجد في البوابة جنوداً يشبهونني بسحنتهم. ص 198 ) ، حيث التصدع البنيوي يترجم تلك السلوكيات ويتعهد بها لتكون شاهدة على المزيد مما هو كارثي تباعاً وتالياً..
ولوذ الكاتب بنفسه يمثّل صرخة مدوية بدلالاتها( أختبىء في حقيبتي التي دخلتُ بها بلدي البديل، فارى وجهي الذي نمت عليه ندوب وأشواك ..ص 189 )، حيث تتوقف السيرة هنا، وهي غير مكتملة كما هو المشار إليه في النهاية بـ " يتبع "، ولكن ذلك لا يخفي وجع المصير الذي يعرّف بالكاتب وهو في عالم آخر، وهو المتشكل في حقيبة مهربة، أو في حقيبة لامبالية بأمره .
ما هو مقروء في النهاية المرسومة، هو: ترجمان الآلام في عالم الأوهام، وهي التي تلزمه في أن يصدّق أن الذي يعيشه حقيقةً، ليس كذلك، ليستمر في الحياة، وهو ينزفـ وهو مأخوذ بين عالمين، لا يخفيان عليه، قلقه النافذ إيلاماً داخله، ولا يتستران على كونه المنذور للعجاج الذي يشبّح الشخص، ويمنع الرؤية الدقيقة للأشياء، بمقدار ما يهدد العين بالعمى وضيق التنفس.
وإذا كان هناك ما يستوجب الإضاءة أكثر، فربما أمكن القول أن في " سلالة العجاج " وما يؤخَذ به في التحديد، ما يذكّر بجانب حي وبليغ في " طفولة برلينية " بدعة فالتر بنيامين السّيَريَّة، حيث إنها كتِبت في ضوء الحياة الكارثية التي كان بنيامين المفكر الناقد المترجم والمؤرخ والفيلسوف والروائي على طريقته، يتحسسها، ويلقّمها قلمَه تعبيراً عما كان يراه في مجتمعه البرليني، وما سيؤول إليه أمره، وتخوفه من الآتي. وربما بالصيغة هذه سيبقى محمد المطرود طارداً وطريداً.
تُرى، ماذا بقي من سر يسمُ عالم السيرة، ويموقعه مكانياً، ووكما انشغل به المطرود، ولم يجر هتْكه، ويشكل محفّزاً على البقاء والدفاع عنه، حيث يكون الفن، وبدعته؟









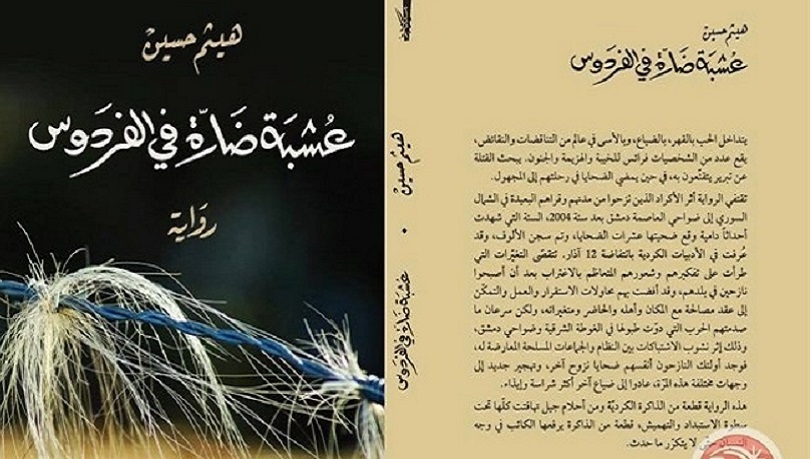






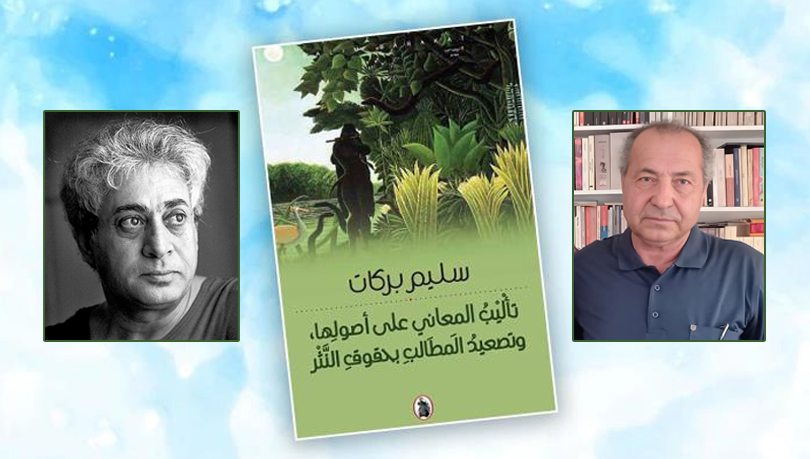

0 تعليقات