ربما من بين أهم مآثر قول الشّعر أنه حين يتكلم بلغته الخاصة، يترك شاعره وراءه، ليس تلبية لرغبة مخطَّطة من قبله، وإنما إرادة قول الشعر هي التي ترسم هذه العلاقة، وهي التي تضفي على قائله تلك المكانة الاعتبارية التي تحيل قول ما كان محوَّلاً إلى ما سيكون، كما لو أن الشاعر يعيد ولادته "نشأته الجديدة" بالشعر مستمراً به، وهو يحمل ساعته ذات النشأة الشعرية.
وإزاء ذلك ليس في الإمكان توثيق واقعة هنا، وهي تخيلية، وهي أن أول ما صدر عن الإنسان، ولو في هيئة حركة في صدمة الوجود، كان منتمياً إلى الشعر، أو كان الشعر نفسه، سوى أن المفهوم المركَّب للشعر والذي يتفاعل عبْره المتخيل الواقعي، هو الذي يعزّز هذه الكلمة الأولى في تأريخه غير المدوَّن. وأقرب دال على ذلك، إن قاربنا بنية المحتوى فيه، هو أن الشعر في جوهره وليد الدهشة والإدهاش: دهشة المرئي وإدهاش المخاطَب ، وفي ذلك يكون عزاء الموجود بلاتناهي الوجود، والرفْع من الحسي اليومي إلى سوية الديمومة المؤمَّمة.
أتراني أطلتُ أم بالغت فيما تقدم، وأنا أريد أن أصل القول ببدعة الشاعر السوري صقر عليشي " تولد 1957 " والتي تمثّل الأساس المكين ، أي : كتاب التلميحات الأحدث صدوراً، لتتعمق تجربته في قول الشعر، وليكون للشعر بالمقابل شاهد إثبات لا يساوَم وهو أنه يعيش تحليقاً باللغة التي تشير إليه، في زمن مديد يؤرّخ لتجربته تلك، بدءاً من " قصائد مشرفة على السهل – 1984 "، مروراً بـ " قليل من الوجد- 2000 " و" عناقيد الحكمة- 2007 " وليس انتهاء بهذه المجموعة الشعرية الصادرة حديثاً، فقراءتها تعلِم في بنيتها عن أن هناك المزيد طي الوعد . أي حيث تعمل ساعة تلميحاته بدقة لافتة.
يأتيك بالنبأ الشعري الملهِم
كيف يأتي " كتاب التلميحات " بتلميحاته ويتعدى هامش الكتاب، الكتاب نفسه، أبعد من حدود التأطير؟ بدءاً من العنوان الذي لم يُؤتَ به اعتباطاً، إنما جعل السماء في لاتناهيها محط متخيله، حيث التلميح يُسمّي نفسه خارج أي حمولة واقعية يومية. التلميح يشد إليه السمع والبصر، إنه يغذي فضولاً معرفياً، أشبه بالحلم الذي يكاد ينقلب واقعاً من فرض غوايته. والشاعر ساحر، لعوب، ولا تخلو صنعته من الخلط بين النجوم التي هي كلماته، بين أسمائه التي يجري استحداثها، ليكون له عالمه، بشره، كائناته الأخرى، حياته وموته بمعايير مغايرة للجاري واقعاً.
يقع التلميح في الخط الفاصل بين آخر مد لليل، وأول مد لإشراقة الصباح، ليكون في مقدور الشاعر الاستلاف منهما معاً، ثم ليكون في مقدوره أن "يضرب ضربته" أو "يلعب لعبته" في توأمة الحالتين وصهرهما بلغته الخاصة.
في التعريف بأعمال الشاعر الفرنسي المعروف موريس مولبوا، يكتب أنتوني دوفريس ما هو محقّق لهذه المعادلة ذات الصدى بلغته الفرنسية (بتواضع غير محدود ، يتحدث مالبوا عن البرد الذي يمس القلب. ولكن أيضًا هذا الدفء من العاطفة العميقة affection profonde ، بدافع الولاء لأحبائك، عليك أن تستمر في الوخز ، بأفضل ما يمكنك ، حتى لو كان ذلك يعني حرق نفسك. لذلك يحاول الشاعر التمسك بالكلمات على أنها أغصان. ).
هوذا قول "الحق" الشعري، عندما تكون القصيدة واقعاً في مكان آخر جهة التعريف بها عن أنها (ابنة الدهشة Fille de l’étonnement ) وميزة الخصوبة في كامل جسدها وفي استغراقها لما هو كوني.
وهو ما أفصح عنه مولبوا نفسه في جوابه على سؤال "ما هو الشعر ؟" في قالب مقال ترجمتًه ذات يوم عن الفرنسية، ومن ذلك (ولجعل هذه الحياة أقل عبثية هو ما قد يطلبه المرء من الشاعر. فلا تقم بتجميله بشكل مصطنع ، ولا تخدعنا في حقيقة الأشياء ، بل أظهر لنا ما هي العجينة التي صنعناها ومقدار الأحلام والرغبة في التكوين في الوقت الحاضر. ).
وإذا كان لي من علْم يمكنّني من الحديث عما يكونه الشعر، وعما لا يكونه، وكيف، فلعل المتردد هنا يكون مفيداً.
إذا كان لي من نعمة حديث عما يمكن المضيّ بالمعطوف على ذائقة الجمال ذات الإمضاءة الشعرية، ففي الذي أطلق له العنان محلّقاً أو مفلتراً على طريقته في رحابة قرطاسه تلميحاً لا تصريحاً.
في "كتاب التلميحات" نتلمس ذلك القاموس "الصغير" لجملة الأسماء التي تعرّف بما هو كوكبي إجمالاً، وطي كل اسم، وهو عنوان ينتمي إلى عائلة الكتاب، ما يضيء صفحته تلميحاً وما يسبغ عليه عذوبة وإقلاقاً للغة الواقع.
وما أراه في سَداد القول المحْكم هو أن الشاعر الذي يعيش واقع بلد متشظ منذ دزينة من السنوات وأكثر، وعنف الجاري بالمقابل، لا يخفي هذه الترجمة، على طريقته، حيث إن سهم التلميحات ينوع في جهاته ويهذّب تلك اللغة التي تسمّي اليوم، وقد أكسِبت شفافية رؤيا، وعافية تعبير، وزهو المؤتى: لمحة تاريخية- عن سيرة الأفق- مع المعرّي- عن الدروب- عن الريح- عن الجبل- عن السماء- عن الغيم- عن الفراغ- عن الغبار- عن الإنسان- عن الحرب- عن بلادي- عن الشعر- عن المنام- عن الحنين...إلخ.
وكأن أفراد هذه العائلة يتقاسمون عبْره ما يجري وما يمكن أن يجري وما مؤمَّل من جهة الشاعر نفسه.
في ليله المعتم، يتنفس نهار، وفي صخرته الصلدة ثمة لسان حال نبع ماء يتدفق، وفي واقعة ضار ٍ ثمة ترويض لقوته لصالح القصيدة، والقصيدة لصالح الحياة، والحياة ، وهذه لصالح الآتي، حيث نكون سكنى أفق انتظار!
ولا يعني ذلك البتة، أن الشاعر يتموقع في "المستحيل" ضبط صورته، أو جهة صوته. ثمة ما يصلنا به، ما يقرّبنا منه، في التعبير عما دفع به لأن يعنون مجموعته هكذا، بعناوينها المختلفة، وبدءاً من كلمة الإهداء: إلى عظية مسوح، أعمقنا وأنقانا . حيث إن كلمة الإهداء لها جهتها ووجْهتها، والشخص الذي سمّي في مجتمعه، وطبيعة علاقة الشاعر به، حيث لغة لمتكلم الجمعية تشير إليه وما يشغله بالمقابل مجتمعياً، إنما ضمن فضاء واسع، لا يؤطَّر بصيغة معتقدية أو إيديولوجية مباشرة.
ما لا تقوله القصيدة
ربما هوذا المحقّق لنِصابه الجمالي في قول المتوخى شعراً، وهو وليد مخاض معاناة.
من الصعب هنا، إن لم يكن مستحيلاً التوقف عند مختلف العناوين، فكل عنوان موصول بالبقية، وهذا التساوي لا يعني غياب التباين في الموضوعات وطرق معالجتها شعراً، وإنما حيث أعطي لكل عنوان ذلك المدد التخيلي المختلف من نوعه عن سواه، ليكون له حضوره وأهلية تدفقه صوب الآتي، أبديته، إن جاز التعبير.
ما لا تقوله القصيدة هو الذي يغذّي إرادة البحث عن المشع داخلاً، فالخفي لسان حال القصيدة، رغم أن القصيدة لا تنغلق على نفسها، بمقدار ما تنفنح على المفارق الحسي لها وفيها ، ولا تخفي جمال " السرد " المميّز لها، إنما وراء الشفافية ما وراءها .
ما يخص " لمحة تاريخية: بانوراما "، وفي التاريخ هذا ما يعزل التاريخ عما كان، وهو ملحَق بحكم الزمان وما ينبغي أن يكون عليه في واقع حاله شعرياً. وبلسان حال شاعره نفسه، وفيه جمع غفير :
طرتُ سريعاً
طرت سريعاً جداً ...
أسرع من ريح عاتية
ومخرت عباب سماوات عالية
لم ينجُ علوٌّ فيها منّي
ورأيت جبالاً، حانية الهامة،
تمرق من تحتي
نمتُ،
وكان الغيم يسير وئيداً
أدنى من تحتي ..ص 7
لدينا هنا ما يشبه كشّاف الحقيقة، حيث العناصر المسمّاة هي شهوده، هي عيونه الدالة على ما يثيره وجدانياً، لا بل في كلّية نفسه، وما يرفع من سهم حقيقة الجاري بين جنبيه، وإحاطته بالذي يتمخض عنه الواقع بملابساته ..
وما يخص " لمحة مع المعرّي ":
لو أن المعرّي أدار عنايتَه
لحديثي ونصحي
لعاش طليقاً،
ولم يتغضن به العمر
وهو رهين المحابسْ
ولو كان يقرأ شعري
لما ظل في الهم والبؤس
جالسْ " 22 "
ربما ما الصعب اكتناه المسافة الفاصلة بين الشاعر ومعرّيه، وما يمكن قوله في النسيج الشعري، سوى أن الذي يظل محفّزاً على النظر، ورؤية الصور المتشابكة، هو ما لدى الشاعر مما تبيّنه في حياته، مما جعل من المعري مجالسه والمصغي إليه، وليس أن يبقى كما هو المعرَّف به" رهين المحبسين ". وما يقوله الشاعر يكاشف فظائع زمانه.
وفي تركيبة فنية، جهة التلميح، يمكن النظر فيما ضمَّنه " لمحة مع أبينا آدم ":
لم يكن جدَّه القردُ
-أستغفرالله-
هذي من الشائعات
لم يعش أي جد له
في مجاهيل إفريقيا،
أو على شجر الجوز في الهند
يقفز من فوق أغصانها
العالياتْ
لم يشاهَدْ
لأجداده ذنَبٌ
يتدلون منه هناك
وأثناءها
كان في جنّة
عرضها
عرض هذي السماوات والأرض،
يمرح بين الظلال وحيداً
يغطّي سوأةً ورق التين
يخصف منه
وما كان صاحب علم غزير . ص 34 .
لدينا مقاربة بلغة الشعر، ومجابهة لواقعة لا بد أنه تفرض نفسها على ذائقة الشعر، ليقول ما تقدَّم ذكره كاملاً. وليس في الإمكان الإحاطة بمكنون الشعر، إنما هو الدفع بقارئه لأن يعيش محنة ما، عالماً منسوجاً بلغة الشعر، وكيف أنه يفجّر خيالات تترى، ويدع كل قارىء من قرائه لأن يختار أباه على طريقته، ويبقى المرجع هنا شعرياً: الشاعر.
وما مضى به في سياق " لمحة في الشعر " وما للعنوان هذا من تجذير المعنى أكثر، وليس " عنه " كما لو أن حرف " في " ترسيخ القول، وتأكيد المغاير في هذا العنوان المغاير للبقية ، وفي لمحتين:
أريد الكلام بأجنحة
في القصيدة
كيف تحلّق متعتُنا عالياً
دونها
وكيف تطير المعاني
إلى أفق من ذهبْ؟!
ليأت الكلام بأجنحة النسر
-إما أحبَّ-
يجوب بها في فضاء البعيد...
يصيد: العلا
والرؤى
والرتَب . ص 41 .
تُرى، هل يمكننا الدخول في عملية المكاشفة الدلالية لهذه القصيدة؟ أم ترْك ذائقتنا على حالها دون تفسير؟ عملاً بقول القائل، وهو أن التفسير في الحالة هذه يسيء إلى محتوى القصيدة بالذات، وهذا يعني أن الذي يمكن القيام به، هو ما يمكن للقصيدة أن نلهمنا، أن توجّه نظرنا إليه، وأن تمنح متخيلنا حضوراً آخر، جميلاً لما يوسّع أفق رؤيتنا تماماً .
في لمحته الأخيرة " لمحة عن الحنين "، ما يصلنا بما كان، وما يعزّز فيه اشتهاء الآتي:
هذا حنينٌ
زاد عن حدّنا
قلَّب الأفق علينا
وفاض
وقد محا منه على كيفه
فما تبقَّى
غيرُ واهي البياض
كم خلقَ الحنينُ
من نهنه ٍ!!
ليس على خلْق ِ الحنين
اعتراض . ص 116.
الحنين اعتراض على الحاضر، توقٌ إلى ما كان، واستعجال بوجوب تحقيقه لاحقاً، لأن الزمن يتجه إلى الأمام، وما في الحنين يكون نظير مأساة، أو محنة، وفي الحنين ما يقلق وما يفلق في آن، وما يجمع جملة القوى النفسية، ما يصل بين الأزمنة المختلفة، ويبلبل المشاعر، إنما لأن في الحنين ما يبقيه مأثرة الروح التي تنفتح على الكينونة، وعلى الإنسان الذي يستحق أن ينظَر في أمره، وأن يجاهَد من أجله، وأن يكون الوجود هدفاً نصْب العين، اشتهاء للأجمل أو المفارق لما هو قائم. فنحن لا نحن إلا إذا كان هناك مفاضلة بين وضعين، وما يُحنُّ إليه له المكانة المعتبرة، لأن الرصيد القيمي، الجمالي، وما يخوّله لأن يكون التمثيل الأعذب والأخصب للوجود حيث نوجد فيه، وحين الكون في كلّيته مأخوذاً بعين الاعتبار، هو الذي يشكل المحك . كما لو أن ختام المجموعة جامعها، ورافعها ودافعها لأن تكون المجموعة في مستوى اسمها.
بالطريقة هذه يكون الشعر قد أكَّد أنه صالح لأن ينطق بفصاحته الخاصة، وأن تكون له شاهدته الخاصة، ففيه ما يرجعنا إلى البدئي فينا، حيث نعيش براءة الطبيعة عينها، أو ما يجعلنا مأهولين بها.
تحية لصقر عليشي صديقاً وشاعراً ملؤه الحياة وحب الحياة وأهل الحياة الفعليين، فحنيننا مشترك، في هذا المعترك!
ملاحظة: كل الشكر للصديق الكاتب والشاعر إبراهيم يوسف، الذي أرسل إلي المجموعة الشعرية هذه، للصديق الشاعر صقر عليشي، بناء على طلبي.











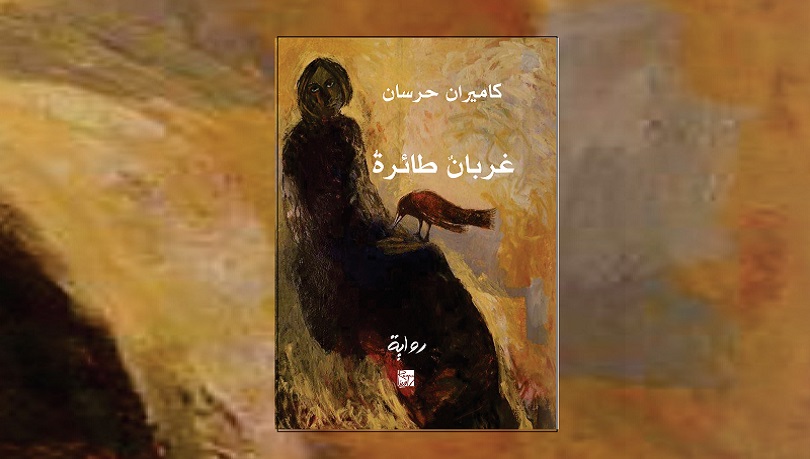





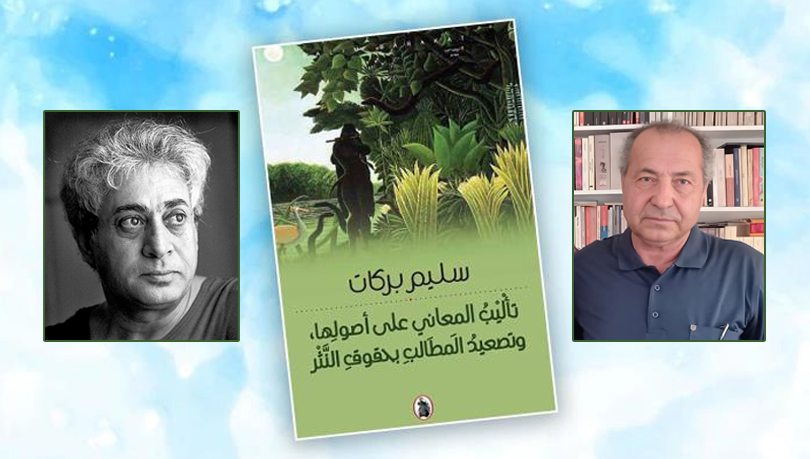
0 تعليقات