من الصعب أن يقتنع الناس بفائدة الفن عامة، والسينما خصوصا، وأن يقتنعوا بقيمة تدريس السينما والوسائل السمعية البصرية، ووسائل الاتصال والإعلام والتكنولوجيا، وأن يعلموا أبناءهم التربية الحقوقية والصحية والجنسية والتعرف على ثقافة الإنقاذ التي تنفع في زمن الجوائح والكوارث والأوبئة، وأن يعلموهم فن الترتيق (L’art du bricolage) كي يحلوا مشاكلهم البسيطة بأنفسهم، وأن يملؤوا أذهانهم بالعلم، ويحرصون على تدريسهم للفلسفة والعلوم الإنسانية والآداب كي لا يكونوا ضحية للتزييف والتمذهب المنغلق.. فتلك أمور هامة وحاسمة في الرقي، وصانعة للفروق بين الأشخاص والمجتمعات والأمم، وهي بأي حال من الأحوال من الأمور الثانوية، وليست ترفا ولا فضلة، فقد كشف وباء كورونا المستجد (Covid 19) عن أولويات كثيرة في بلادنا، وبعض البلدان الأخرى، وإن كانت الانهيارات قد فاجأت الجميع لأن الثقة الظاهرية فيما نعتبره حقائق يكون معكوسا في الغالب، بل قد يؤدي للكارثة.
********
بدا أن الاستثمار في التربية والتعليم أولوية الأولويات، فالطبيب والممرض والصيدلي ورجال المختبرات (البيولوجيون) يكونون في الواجهة، لكن هذا لا يعني أن الأزمة تكشف بدورها عن الأعطاب التربوية المخيفة للبعض كغياب المسؤولية (حالة طبيب تطوان)، والجشع واستغلال فرص التوتر، وقلة الموارد، وفساد المسيرين، وتعاظم اللوبيات المتحكمة في الأدوية والصحة إن على المستوى الداخلي أم الخارجي (حالة الطبيب الفرنسي ديديي راولت)، فقد أظهرت قلة من هاته اللوبيات تضامنها المادي مع الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا.. وهنا بالذات تظهر قيمة التربية الحقة التي تجعل الضمير يقظا ومتزنا، وتجعل الشخص مستحضرا للقيم الإنسانية العليا، متضامنا وعطوفا ولينا في حالة الشدة.. أليست المدرسة والأستاذ من أوكلنا له القيام بهذه المهمة، سيما وأن أرباب الأسر قد تلقوا تعليمهم وتربيتهم على يديه قبل أن يكونوا أصحاب مهن وآباء وأمهات؟ فلنفكر سويا في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وللمربين والأساتذة، ولننتبه إلى مستغلي المحن والضائقات وبائعي الأوهام وخوصصتها!
كشفت الأزمة عن أولوياتنا، كالاستثمار في العلم والبحث العلمي، وإرساء منظومة تعليمية وفكرية وثقافية وفنية قريبة من الناس، مُهْتَمَّةٌ بالإنسان (أولى الأولويات)، فالسياسة الحكيمة تدعمهما المجتمعات الواعية لأن حكم الواعين والمتعلمين سهل مهما كانت انتقاداتهم قاسية كما أن معارضة المثقف، ونقده المباشر لما يقع في بلده تطويرٌ ودعمٌ لمسيرته ونمائه.. والدليل، ها نحن نستيقظ اليوم على ظواهر يجهلها الكثير ممن لا يَحْتَكُّونَ بالناس في الحياة وفي أقسام الدرس وفي المهن المباشرة.. لقد آن الأوان كي نتعرف على بعضنا البعض، وأن نرقى بمن نراهم اليوم غير قادرين على مواجهة المستجدات والطوارئ كي لا يكونوا ضحية لخفافيش الظلام الذين وجهت لهم "كورونا" درسا لن ينسوه في حياتهم: استغناء الناس عنهم واستنجادهم بالعلم والمتعلمين سيما بعد أن أغلقت أماكنهم الأثيرة، الواحدة تلو الأخرى!
لست مع ولا من الذين يحتقرون الناس الأميين، وغير الواعين مع ضرورة الفصل بينهما، فليس كل أمي غير واع بالنظر إلى اختلاف التجارب الحياتية والتأثر بالناس الواعين والمتعلمين، فضلا عن اختلاف الطموحات الشخصية.. هؤلاء منا، منتوجنا المحلي، ونحن نتالم من تصرفاتهم العفوية والاضطرارية (الحاجة والخصاص)، ونكتوي بتصرفاتهم.. فلنعترف بأنهم أبناء هذا الوطن الذي فشل في إِقْدَارِهم (Rendre capable) على فهم درس الواجب والمسؤولية والحرية والحق.. بل، من الأجدر الانتباه إلى أن فئات سياسية معينة قد خافت – وهذا سوء تقدير فظيع منها – من مرور هؤلاء من ضفة الجهل إلى ضفة المعرفة والوعي، ظَانَّةً بأن مصالحها ستصبح مهددة؛ إذ الظاهر أن حصولها ووصولها إلى ما هي عليه لم يكن مستحقا ودون مؤهلات، وبشكل غير ديمقراطي: هيهات! من يستثمر في الجهل كي يستفيد منه لن يحصد إلا الجائحة! أثبتت التجربة أن من يكد من أجل شيء معين يخاف ضياعه، ومن ينل شيئا دون جهد يخسره بسهولة، وأن ما بني على باطل يتهاوى، فجأة كليا، وبشكل فجائعي.
تختبر المجتمعات (والدولة طبعا) قوتها وقدرتها أثناء الشدائد، وتكتشف هِنَاتِها بفضل ما يحصل بين مواطنيها، وها نحن اليوم نصل إلى بعض من نقط القوة والضعف معا: ظهور قوى (العبرة ليست بالكم) وأصوات وطنية، طليعية، مثقفة، واعية، متضامنة، منتقدة، مسؤولة، متآزرة، منخرطة، مغامرة، مضحية.. في مواجهة قوى (كثيرة) أخرى حاقدة، مندفعة، غير واعية، جاهلة، ظلامية، مُسْتَغِلَّة، مُحَرِّضَة.. وقد ظهر بالفعل أن الأولى تواجه الثانية بشكل غير مقصود، لكن الظرفية كشفت ذلك بالملموس، فقد ظهر الانتهازيون وتجار الأزمات والمتربصون والمتلاعبون والمتشفون والحاقدون والمستهترون.. والنتيجة: إن تكلفة الاستثمار في الجهل والأمية باهظة ومكلفة (وليعتبر المعتبرون!).
بالفعل، جعلتنا جائحة الفيروس التاجي نفقد تيجاننا التي طالما تباهينا بها، ونخسر أقنعتنا التي اختبأنا وراءها، ونكتشف رهافة يقينياتنا المطمئنة: آه، نحن متساوون أمام الموت، والصديق مستعد لإغلاق بابه كلما أحس بالخطر، والعَالَم الذي طالما شيدناه مزهوين بجسارته يسير نحو التوحش والانهيار.. آه، نرى بأن المعنى يتحطم في أنفسنا نحن المرهفين، الحالمين، المنافحين عن العدالة والحق.. لكن، فلنتشجع، فهناك بصيص من النور يلمع في الأفق البعيد: إن البشرية مستعدة دوما بفضل فضلائها للملمة جروحها، ولإدراكها العميق والتراجيدي بأن إنسانيتها تنبني باستمرار، وأثناء إحساسها البليغ بأن مراجعة الذات تتطلب لحظة الاندهاش الناتج عن الذعر، وبفعل قدرتها على تشخيص الآلام ورفع الهمم، فإحصاء الموتى يدعو للتفكير في الحياة أكثر، وكفكفة الدموع متبوعة بتدفقها في حالة الفرح!
********
وأخيرا، بدأت بالفن وسأنتهي به، لقد ظهر بأن ملاذنا في حالة الضيق مكتباتنا: نعيد اكتشافها، ونستنير بأنوارها.. وأن السينما (مكتباتنا الفيلمية) ملجأنا في العزلة: تعزلنا عن العَالَم كي تضعه بطريقة أخرى أمامنا.. وأن النغم والطرب والموسيقى (مكتباتنا الصوتية) خير مؤنس لنا حينما يجتاحنا ضجيج الموت وصمته الرهيب.. وأن ما جمعناه من أعمال فنية (لوحات، صور، منحوتات...) يجعل منازلنا آمنة وجميلة ومفعمة بالحياة.. ألم يحن الوقت بتعميم التربية الفنية بكافة أنماطها عساها تطرد القبح المبتوت من حولنا؟
يعلمنا الفنُ التَّبَصُّرَ، ويُدَرِّبُنَا على الاختلاء الطوعي التأملي، ويقيس درجة إحساسنا بالراحة الداخلية التي تحتاجها كل ذاتٍ لتحقيق التوازن في الحياة.. أليس الفن هو تلك المؤسسة الإنسانية المفتوحة التي نعود إليها كلما طردتنا المؤسسات الأخرى؟ للفن قدرات كبيرة على استبطان الذات الإنسانية، والتنبؤ بما يمكن أن يقع لها من أزمات، فقد ثبت بأن كل الخيالات الفنية لم تكن شططا، وهاهي تصير اليوم واقعا متجاوزا، وتلك قدرة الفنون عموما، والسينما خصوصا، على التنبؤ.. فالخيال ينعش الذهن، وينقذ الذاكرة، ويدعم الجانب الإنساني فينا.. بل، وينبهنا باستمرار للعودة إلى الذات، وتأمل جمال الحياة حينما نتعرض لأقصى الهزات وأعنفها. مثلا، حينما تعرض السينما حالات الخوف والفزع، وهشاشة الإنسان أثناء الألم والمرض، وتعري ضعفه أمام الموت، فإنما لتعلمنا نعمة الفرح واللذة، وتختبر قدرتنا على الاعتراف بالآخر.. وعليه، ها نحن ندعو إلى تغيير رؤيتنا الدونية للفن لأن كبار الفنانين قادرين على استشراف المستقبل: تناول فيلم "عدوى" (2011) للمخرج الأمريكي "ستيڤن سودربرغ" لاجتياح فيروس قاتل للعَالَم؛ وتناول المسلسل التلفزيوني "My secret terrius" (2018) للمخرج الكوري الجنوبي "بارك سانغ هون" في الحلقة 10، وفي الدقيقة 53 منه حوارا حول الفيروس الذي يجتاحنا؛ وتنبأ الروائي الأمريكي "دين كونتز" في روايته "عيون الظلام" منذ 1981 بظهور نفس الفيروس أيضا.. قد نفترض أن الأمر مريب للغاية، لكن قدرة التخييل والتصوير وإدارة الأحاسيس عمل فني خالص ومثير للغاية أيضا.
محمد اشويكة كاتب وناقد سينمائي مغربي. له العديد من المؤلفات في الحقل السينمائي.
مراكش في 28 مارس 2020.







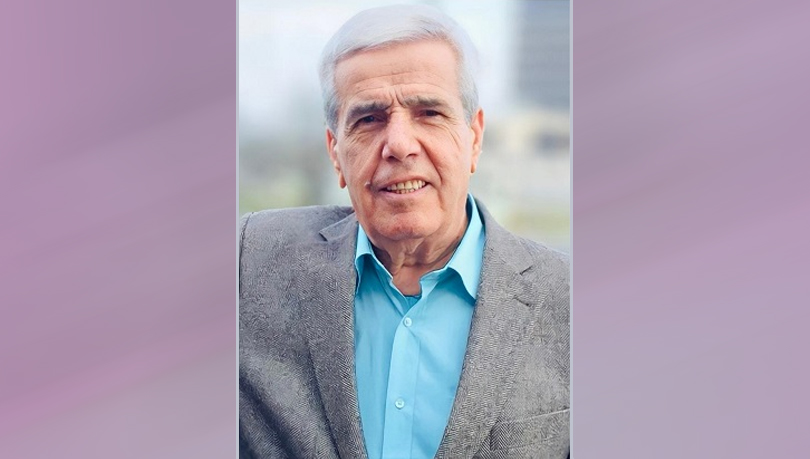

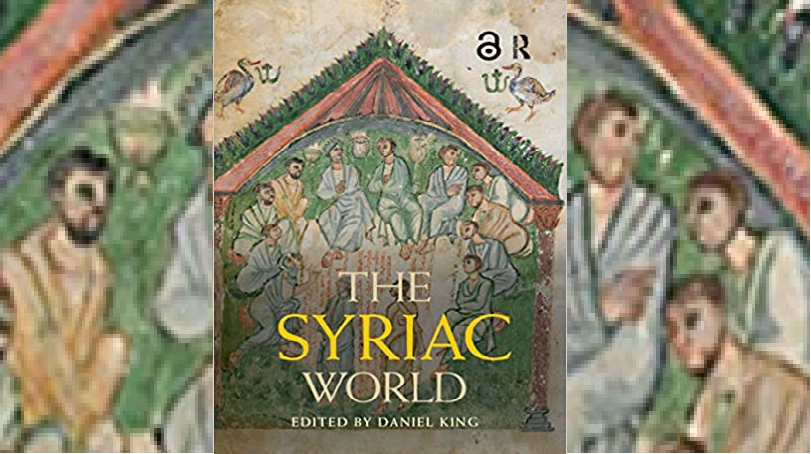






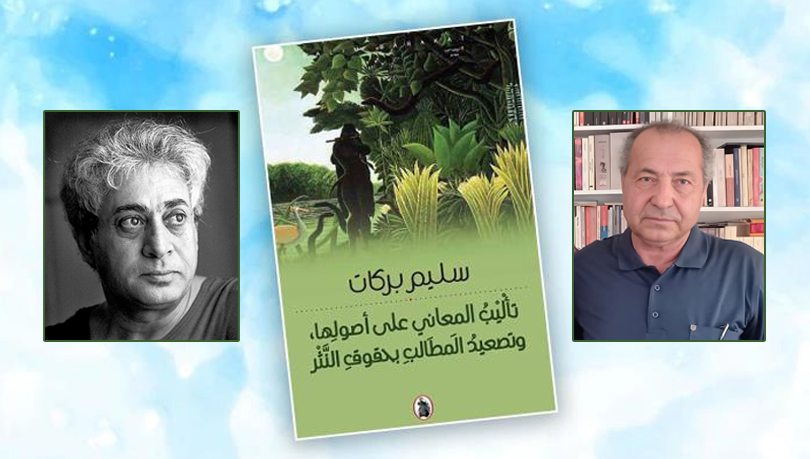
0 تعليقات