لا شكَّ أنَّ المشهدَ الشِّعريَّ في راهنهِ الآن يفتقدُ إلى تلك «الانعطافة الشِّعرية»، التي تفرض عادةً إعادة النَّظر في استراتيجيات الكتابة الشِّعريّة، وكذلك في عملية التلقي ذاتها، ولكن في مقابل هذا الافتقاد المريع يتيح لنا المشهدُ الشِّعريُّ تلمُّس بعض الحساسيات في الممارسة الشِّعرية هنا وهناك تتوزَّع في جغرافية هذا المشهد. وإذ أستخدم مفهوم «الحساسيّة الشِّعريـّة»؛ فإنني أقصدُ به تلك الممارسات الشِّعرية التي تتوفَّر على محاولةِ نزوعٍ مختلفٍ ومغايرٍ في عملية تمثيلRepresentation الذات في علاقتها بالعالم واللُّغة والكتابة الشِّعرية ذاتها، وبمعنى آخر ثمَّة محاولة جريئة من لدن هذه الممارسات على إعادة النَّظر في سياسة الكتابة الشعرية للمرحلة السابقة، وفي هذا الإطار تأتي المجاميع الشِّعرية لجولان حاجي ورائد وحش ورشا عمران بوصفها نماذج تمثيلية لهذه الحساسية على أمل الزجّ بنماذج أخرى في قراءات لاحقة.
Iـ ثمَّة من يراك وحشاً وأناقة اللُّغة:
ثمَّة خطوةٌ جريئةٌ يخطوها «جولان حاجي» في مجموعته الجديدة « ثمَّة من يراك وحشاً »([1])؛ وَلْنَقُلْ إنها خطوةٌ مضيئة باتجاه الشِّعر، الشِّعر من حيث هو استنفار اللُّغة من سُباتها، والدَّفع بها نحو المغايرة والتَّجدُّد، ولهذا سيلمسُ القارىءُ ذلك الاشتغالَ على اللُّغة وبها؛ لتكن الأناقةُ، أناقةُ اللُّغة بالتأكيد، هي الشُّغل الشَّاغِلُ للشَّاعر والعلامة الأبرز في الممارسة الشِّعريّة لديه، وحتى تكون هذه الأناقةُ السِّمَةَ المهيمنةَ للكتابة الشِّعرية فقد لجأ الشَّاعر إلى ممارسة الاقتصاد اللغوي بالتعاضد مع الاقتصاد النَّصيِّ، فالنُّصوصُ المكوِّنة للمجموعة غالباً ما تكون قصيرة وملغَّمة بالكثافة دلالةً.
بيد أنَّ ما يميّز كتابة «جولان حاجي» في هذه المجموعة هو اتّباعه استراتيجية جديدة في بَنْيَنَةِ النَّصِّ الشِّعريِّ مفادها اللّعبُ بمستويات الخطاب بحيث يفاجئُكَ النَّصُّ بانبثاقاتٍ غير متوقّعة على صعيد المعنى عبر التَّحولات الدلالية من سطرٍ إلى آخر، ولذلك فالمعنى يباغت القارىء في غفلته ومن حيث لا يتوَّقع؛ لأنَّ اللغة لا تَنِيْ تتقدَّم في خرائط العَالم تلتقط اللامرئيَّ فيه، وتؤسس عالماً قائماً على المفارقة وما على القارىء إلا الرهان على استنهاض خيوطٍ غير مرئية للربط بين أجزاء النَّصِّ. ومن هنا فالاهتمامُ باللُّغة لم يكن على حساب العُمق الشِّعريِّ؛ فالكلمة الشِّعرية، هنا، تتمتع بطاقتها على الإصغاء للعالم في حركته وصمته؛ لتتيحَ لنا أن نلمسَ ما هو مهمَّش وفي عهدة الصَّمت، وبكلمة أدق يمكننا القول: إنَّ الشاعر في «ثمة من يراك وحشاً» يُبَأّرُ الخطابَ الشِّعريَّ؛ ليكون وطناً للامرئيِّ بامتياز كامل. وإذا كانت الكتابة في خطوطها العامة كذلك؛ فما شأن النَّصِّ، وما شأن الشِّعر فيه: ينجح «جولان حاجي» إلى حدٍّ بعيدٍ في تشفير السِّياق الشِّعري للنَّصِّ والكلمة؛ ولذلك تغوي نصوصُهُ القارىءَ بخوض مغامرة التأويل بمتعةٍ، إذ القارىء يجد نفسَهُ في كلِّ نصٍّ إزاء متاهةٍ تدفعه إلى التيه والمجهول ومعانقة السَّراب، وهذا دَيْدَنُ الكلمة الشِّعريّة ذاتها في عدم الوفاء بالتَّحديد دلالةً، والفرار من السُّقوط في أوحال المعنى الواحد هويةً ومطابقةً:
«كلُّ كلمةٍ بابٌ ينفتحُ على اللانهاية.
الدَّرجُ الذي أصعدُهُ
لا يفضي إلى أيِّ مكانٍ.»([2])
ربما تعكس هذه الشَّذرة النَّصية «سياسة» الكتابة الشعرية التي يقود بها الشَّاعرُ الكلماتِ إلى سياق النَّصِّ، سياسةٌ لا ترتاح إلا الغامض والمكنون والإيماءة والإشارة ومواجهة التحديد والمطابقة باللانهاية والاختلاف. إنَّها سياسةُ الكلمة الشِّعريـّة في مساكنة اللانهاية واللاستقرار؛ ولهذا فالنُّصوصُ في هذه المجموعة تؤسِّسُ للممكن والمحتمل واللامتوقع والمباغت، وبمعنى آخر: فالكلمة الشِّعرية تقود قارئها إلى مشارف الضباب، حيث «الكلمة» تأخذ شكلَ الباب وهيئةَ الدَّرج اللذين ينفتحان على مغامرةٍ غير محسوبةِ العواقب؛ فحدود الشعر حدود «اللا ـ مكان»، وبهذه السِّمة، سمة الإرجاء الكليِّ، والانتثار الدلالي، فلا موعدَ ثابتٌ مع تحقُّق المعنى لهويته، فالمعنى يتقن لعبة الحضور المؤقَّت والمفاجىء؛ لأنـَّه على موعدٍ مع فجوةٍ لا قرار لها من الغياب؛ ولذلك يخلق الشِّعر العطش إلى التخيُّل، ويفتح إمكاناتٍ جديدة لفهم العالم. إن حركة الكلمة الشعرية غير متوقعة أبداً لدى جولان حاجي:
«ككلمةٍ وحيدة
تئنُّ وتركضُ في البياض
من ورقةٍ إلى أخرى
شعلةً في قبضةِ إلهٍ أعمى»([3])
إنَّ «الكلمة» في الفضاء الشِّعريِّ، في فضاءِ القصيدة، إنما تستعيدُ كينونَتَهَا وطاقتَهَا على الإضاءة والإنارة؛ لأنَّ التداول يُسلِّعُ «الكلمة» ويفقدُها هذه الطاقة على الانفتاح والتبدِّي، ولذا فلئن كانت الكلمة الشِّعريـّة شعلةً، قنديلاً، فإنها تلك الشُّعلة التي تقودُ إلهاً أعمى، شعلة تتيح للإله أن يتلمَّس طريقه نحو الحضور؛ لأنَّ الكلمةَ الشِّعريةَ، بل الشِّعر هو المنفذُ، والممرُّ الذي به وفيه يتجسّد الإله ويغدو في متناول الحضور ومن ثمَّ الفهم، فمن وظيفة الشُّعلة أن تضيء، أن تؤنسَ عزلة الإله الأعمى في عتمته الخالدة، الكلمةُ شعلةٌ ليس لأنها تنير الدرب للإله الأعمى، بل لأنَّ الكلمة تُقالُ لكي يكون الإله ذاته.
إنَّ حركة المعنى في نصِّ «جولان حاجي» هي من حركة الكائن في النَّصِّ ذاته، ليس ثمَّة ما هو ساكنٌ، فالمجد للحركة، للنَّوسان، للتحوُّل:
«سأزاولُ مهناً أمقتها
وأنتقلُ بين منازل ليست لي
ستتداعى في أيةِ لحظةٍ
وأعاشرُ أناساً
لن أصبحَ أبداً واحداً منهم.
لقد حُذِفَتْ حياتي
وما تبقّى ليس إلا
الهوامش انتثرتْ كالفتات
على حوافّ ورقةٍ وسخة
اقرأ فيها صمتَ الإشارة
وألمحُ موتَ اليقين.»([4])
القصيدة تمجّدُ «التحول» و«الانتقال» و«العبور»، إنَّها سمات الشّاعر مُدَشِّنُ الكلمة، أو ذلك الكائن الذي تدفعُهُ «الكلمة الشّعرية» لممارسة العبور من المهن إلى المنازل، فالناس، فما يهمُّ ليس المتن/الأساس وإنَّما «الهامش»؛ لأنَّ الهامشَ هو الذي يمنح «المتن» معناه وكينونته، فالهوامش هي ما تبقَّى من «الكائن ـ المتن»، هي التي تضيءُ المتنَ، وتجعلُ المتن متناً، فهوامش الحياة هي التي تمنح الأخيرة كما أشرنا الوجود والحضور، كما لو أنَّ النّصَّ يُشيرُ إلى أنَّ «مـا» يبقى هو الهامش ــ القصيدة، أليستِ القصيدةُ هي الهامش والعرض، التي تخلد الكائن ــ الشّاعر(= المتن)، لكنَّ هذه القصائد (= الهوامش) فيها ما هو أبعد، فيها تكتسبُ الأشياءُ حياةً أخرى (أقرأُ فيها صمتَ الإشارة/ وألمحُ موت اليقين). في القصيدة يغدو الصًّمتُ علامةً، إشارةً، يغدو كائناً برسم التكلّم، لأنَّ الصَّمتَ ليس سكوتاً، وإنّما امتناعٌ عن النَّطق وليس الكلام، فالإشارة ــ الصمت تومئُ، تُشيرُ، تجابه اليقينَ، لأنَّ الشَّعر هو موت اليقين والثبات، والعرف. إنه فتحُ الآفاق وتدشين المستحيل، فصمت العلامات أبلغ من الكلام المنطوق، إنه رنين الغياب و صوت الهامش على أطراف الحياة.
وأخيراً، ثمة إشارة لابُدَّ منها بخصوص مجموعة جولان حاجي وهي تتعلَّق بالبعد الجمالي لعنوان المجموعة، فالعنوان كما يظهر «ثمة من يراك وحشاً» مكتملُ المعنى أي يفتقدُ إلى الفجوة نحوياً أو دلالياً، وهذا ما لا يتساوق مع الإرجاء الدلالي للنّصّ/ النُّصوص، فقانون العنوان يقومُ على إدقاع دلائلي وانفجار دلالي، علامات أقل ومعنى أكثر بيد أنَّ اكتمال الجملة قد حَدَّ من هذا الانفجار.
II ــ لا أحد يحلم كأحد وشعرنة السّطح:
ثمَّة مسافةٌ في الاستراتيجية الشّعرية بين «رائد وحش» و«جولان حاجي»، وكما أشرت سابقاً، فاللّغة تحتازُ على اهتمام كبير لدى جولان حاجي، في حين هناك مشاغلُ أخرى تقع في بؤرة اهتمام رائد وحش في مجموعته «لا أحد يحلم كأحدٍ»([5]). في هذه المجموعة نجد اهتماماً بالموضوعات العابرة، والسَّطحية والتافهة؛ لتغدو تحت طائلة «النَّصيَّة» « textuality نصوصاً شعرية تلفتُ انتباهنا وتورِّطنا في قراءتها؛ للاستمتاع بجماليات السَّطحيِّ واليوميِّ كما في قصائد «سأتزوج أنجلينا جولي، سكن غرف الشّات، حيوانات تزور حديقة البشر، التقويم من وجهة نظر السرفيس، إنّها تمطرُ نبيذاً، على دراجة نارية ......إلخ»، ولهذا سنلحظ أنَّ «سياسة» الكتابة الشعرية تميلُ إلى تمثُّل القيم الما بعد حداثية لوظيفة النّص الشّعري، فالما بعد حداثي هو الذي ألغى المسافة بين الثقافة العالية والثقافة الشعبية، كما ألغى المسافة بين الموضوعات الميتافيزيقية والموضوعات اليومية المفخخة بالحرارة والحياة، ولذلك تحتفي نصوص رائد وحش بخُرافةِ اليوميِّ والمهمّش حياتياً، فليس ثمَّة تقديرٌ واحترامٌ لما هو ميتافيزيقي وأرستقراطي، وإنَّما المجموعة تغدو مسرحاً للثأر من الكتابة الأرستقراطية واستبدالها بكتابةٍ قائمة على إشاعة الضحك في فضاء القارئ، كتابة حارّة، سريعة، وفية لزمنها ولتدمير الأطر المؤسسية للموضوعات الشِّعرية؛ فكلُّ شيءٍ يُقادُ إلى البياض؛ ليكون نصاً وتمثيلاً للعالم من وجهة نظر ما بعد حداثية.
يفاجئنا «رائد وحش» منذ البداية بالتَّحرُّك نحو زاوية الاختلاف، لتأسيس التَّباين والتَّغاير ومشاكسة التَّشاكُل بدءاً من العنوان «لا أحد يحلم كأحد»؛ إذ بكلماتٍ بسيطة، متداولة، يُفجِّرُ في وجهنا لافتةً شعريةً، كما له أنّهُ يقولُ هاكـم الشعر على هذه الشَّاكلة: «لا أحد يحلم كأحد»، وإذا كان الشَّاعر يمارسُ اللعب منغمساً في لذته، فلنمارسِ اللعبةَ ذاتها تأويلياً: إنَّ معاينة العنوان تتكشَّف عن دلالات مضمرة، كما لو أنَّ الشَّاعر يروم قصداً قريباً من ذلك: «لا أحد يكتب كأحد»، فالاختلاف حلماً يستدعي الاختلاف كتابةً، والإبداع يقتضي هذا الاختلاف: «لا أحد يحلم كأحد»، فالاختلاف كامنٌ في الطريقة التي ينسج بها الحلم حضوره وحدوثه في اللاوعي ــ الكتابة، هكذا تترادف العلامتان: «يحلم» و«يكتب» في الدلالة على إنجاز الاختلاف نصياً.
يأخذنا رائد وحش إلى عوالم متنوعة: أنجلينا جولي، شاكيرا، أفلام الكرتون، غرفة الشّات ....إلخ، وفي كل ذلك يُلغِّم هذه الظواهر نصياً بالمفاجآت والدَّهشة، ودائماً ثمة ابتسامة ترفرف على وجه القارئ؛ لنقرأ:
«أنجلينا ....... الحبُّ يجعلنا فنانين
هذا الهوسُ الغامضُ
كفيلٌ بجعل الحمار يرسم
أو ينهقُ قصيدةً
وبالنسبة لي، كحمارٍ على الأقل،
سأحـبُّكِ.
كما لو أنَّ الحبَّ لم يكن من قبل.»([6])
كما أشرت فالقيم التي تقودُ «سياسة الكتابة» تتغذّى بالقيم المابعد حداثية في الكتابة الشعرية، حيث توارى التراتبُ القيميُّ بين الموضوعات والثَّقافات والأشياء، لتغدو الظواهر على مستوى واحدٍ بالنسبة للشّاعر المابعد حداثي، حتى عندما يتخذ من «الأنثى» موضوعاً للنّصِّ، فالأمر مختلفٌ، إذ الرؤية الشِّعريـّة مدموغة بالمناخ الرَّاهن:
«أكثرُ من عاصفةٍ عطرُكِ، يُسمّمُ هوائي بعنادٍ، فأفوحُ بكِ وأظنّني متحولاً إلى نبتةٍ.
يعانقني الآخرون بحميميةٍ لم أعتدها، وحين يشمّونَكِ فيَّ، يرجونني ألا أستحمَّ.
حبّي بالرائحة القاطعة، وأنتِ من قلتِ علامةُ الحبِّ أن تشمَّ الآخر، لو كان في قارة مجهولةٍ.
دائماً، في غيابكِ، عطرُكِ، شقيقُ عبق الصابون، يسدُّ الفراغ»([7]).
ثمة لمسة خاصة، ثمة حساسية في تحويل الظواهر اليومية إلى حالاتٍ نصيّة في نصوص رائد وحش، فهذا التموقع من لدن الشَّاعر في فضاء اليومي يدفعه لتحويل أحداثه وكائناته إلى أبعادٍ جمالية، فالعطر يغدو بؤرةً للنَّصِّ عبر هذا التشبيه المبدع: «أكثرُ من عاصفةٍ عطرُكِ»، هكذا تستولي علامة «عطرك» على ما هو كامن في العاصفة ليحدث الأثر الساحق في العاشق والآخر. بيد أن الشاعر يندفع إلى البوح بالمسكوت عنه على نحو جريءٍ، فتحت عنوان: امنحيني فرصة البهيمة، نقرأ:
«اللحمُ البهارُ
الشهوةُ التي بريّةٌ
تحوِّلُ غرفتي كهفاً.
وأنا الذي خسرتُ بهيميتي
أحتاجُ فرصة الإنسان القديم
لأعرف ما الذي تغير في الحبّ
خلال مليون سنة.
أحاولُ تعلّم العواء
لأناديكِ.»([8])
تُرى ما الذي فعلته الحياة المعاصرة بالكائن ــ الذَّكر، لتفتك بذكورته، وتحوّلها إلى ما يشبه الذكورة، وتفقدها حرارتها وطاقتها على الإخصاب. إنّه الفقدان، فقدان البهيمية، بُعد الرَّغبة، بهيمية الإنسان القديم، لإدراك الاختلاف بين الذكورة راهناً وماضياً، كما لو أنَّ الذكورة قد نسيت ماضيها البهيميَّ لتغدو دون ذكورة، ولهذا عليها أن تتعلّم العواء لتستعيد ذاتها وهويتها، لتستعيد الذكورةُ ذكوريتها التي اقتنصتها الحياة المعاصرة بضغوطها، والتفافها وسحقها للكائن.
إنَّ النّصَّ الشّعريَّ عند رائد وحش يسْعَى إلى قراءة العالم راهناً تحت ظلِّ العولمة، وهي قراءة بقدر ما هي سلبية فهي إيجابية، «ليس من أحد يعرفني، بالأحرى لستُ بأحدٍ، أنا العالم وأكثر!!»، إنَّ كائن العولمة هو مزيج مختلط: «ما الذي سأكونه لو كنتُ من أبٍ مكسيكي وأم إيرلندية، وكانت جدتي لأبي يونانية، وجدتي لأمي مصرية؟ ». لاشكَّ أنَّ القصيدة تنحازُ إلى الحنين للأصول، للأصل الواحد، أو للهوية في مقابل المهجَّن والهوية المتعددة. إنَّ العبارة الأولى تكشفُ أنَّ الكائن المعولم، ليس له ذلك الرسوخ، إنّهُ كائن بلا هوية حسب القصيدة حتى وإن كان يقبضُ على العالم، ويصبح مثار إعجابٍ من خلال مسلسل أو برنامج تلفزيوني، فسيبقى بلا جذور وحيداً مسحوقاً تحت رحى العزلة:«لو أنني هذا، أو ذاك، أو ذلك، وظهرت على شاشةBBC ما الذي سأقوله لهم عن حياتي غير ما يقوله المشاهير: كم أنا وحيدٌ وحزينٌ وتافهٌ؟»، هنا نلمس التهكم والسُّخرية من الكائن المعولم الذي في لحظةٍ ساحقة يجد ذاته تتمزق تحت سعير التشظي والتناثر من غير هويةٍ حسب زعم القصيدة.
III ــ معطف أحمر فارغ وجماليات التأمل:
بعد مجموعات ثلاث «رجعٌ له شكل الحياة»، و«كأنَّ منفاي جسدي» و«ظلُّك الممتد في أقصى حنيني»، تأتي المجموعة الرابعة للشّاعرة رشا عمران «معطف أحمر فارغ»([9])، لتؤسِّس لجماليات الغياب والتأمّل والجسد. تُمهِّدُ الشّاعرة رشا عمران لمجموعتها باستهلالٍ مٌقتبسٍ من ريلكه:
«كل الذين استسلموا لي
اغتنوا مني
وغادروني»([10])
ومن وظيفة الاستهلال الإيماءة إلى عالم النّصِّ المرتقب، الإشارة إلى الثيمة/ الموضوعات التي تمتد على الشريط اللغوي للنّصِّ. هكذا نجدُ أنَّ الاستهلال يمهِّد للقارئ للدخول إلى العالم الذي تتكشَّفُ عنه نصوص المجموعة، إنَّهُ عالم الغياب، عالم الكائن وحيداً، بعد الاحتفاء والحضور الباذخ لدى الآخرين. هذه الشذرة الشِّعريـّة لريلكه سرعان ما تحضر بعنف في نصوص المجموعة، ليضاعف من قوة الغياب فيها:
«ثمّة ما قد يتبادله اثنان في هذا الظلام
غير أنَّ الرِّيح حررت نوافذ البريد من جدرانها
والغربان أنذرت الراقصين بالناي الأسود
طال انتظاري كثيراً
وكل ما حولي قد انسحب باتجاه الجنوب
لم يبقَ شيء
لم يبقَ شيء أبداً
غير معطف أحمر فارغ.»([11])
هكذا تترجم رشا عمران قوولة ريلكه شعرياً، إذ سنلحظ أنَّ الفعل «غادروني» الدَّال على الفراغ والوحدة يتجسَّد من خلال الفعل «لم يبقَ»، ليبق الكائن وحيداً في بريةِ الفراغ والوحشة القاتلة، هذه الوحشة التي تصرُّ على الحضور العنيف في أكثر من نَصٍّ:
«الأضواء في الشَّارع الطويل
الشّارع المقابل لنافذتي
تنطفئ
ضوءاً ضوءاً
ومن بعيد
يقتربُ نحيب البحر
كمن ينحني على وحشته
فقط.»([12])
المتكلمُ في الغرفة، والبحرُ في الخارج، كلاهما تحت وطأة الغياب، كلاهما ينحني على وحشته، منفرداً في عراء الفراغ. وسواء تعلّق الأمر بريلكه أم برشا عمران ففي الشذرات المختارة للقراءة، ثمة غيابٌ عنيفُ للآخر، ثمة افتقاد للألفة والأنس، كما لو أنَّ كائنية الإنسان لا تكتملُ إلا بحضور الآخر، غير أنَّ هذا الغياب سرعان ما يُنْسَف بالدعوة للآخر بالحضور:
«جسدي مكتملٌ بسكون السرير
السرير مكتملٌ بسكون المنزل
المنزل مكتملٌ بسكون العالم
العالم مكتملٌ بسكون الحياة
الحياة مكتملةٌ بي
لا تتأخر.»([13])
تشي الشذرة الشّعرية، بالتناغم المطلق بين مكوِّنات العالم: الجسد والسرير، السرير والمنزل، المنزل والعَالم، العَالم والحياة، والحياة بالكائن، وعليك أيُّها الآخر، الذي لن تكتمل الألفة والعالم إلا بك، أن تحضر، ألا تتأخر، لأنَّ تأخّركَ من شأنه أنْ يشوّش هذا التناغم المادي والروحي بين عناصر الكينونة، حذارِ أن تتأخر عن الارتفاع بالتناغم والانسجام إلى ذروته، فكلُّ شيءٍ مهيّأ لحضورك، لأنَّ هذا التناغم ناقص الوجود، لن يحوز على هويته إلا بحضورك الذي سوف يبثُّ الألق فيه.
تُسجِّلُ رشا عمران أكثر من خطوة على صعيد البنية النّصية ولاسيما في نصيِّ «كم طرية أنا بك» «ضوء ضئيل في الرمل» وذلك حينما تلجأ إلى استراتيجية السّرد وتورِّطه في بناء القصيدة، فاستخدام السرد يقود الشاعرة إلى الزج بالتفاصيل الصغيرة إلى القصيدة الشعرية دون التخلي عن هيمنة الوظيفة الشعرية في النصين المذكورين. مجموعة «معطف أحمر فارغ»، تقوم على مفاجآتٍ شعرية هنا وهناك على طول السَّرد الشعريِّ، فالشّاعرة تُحدثُ طياتٍ شعرية مثيرة:
«كلما قلتُ أحبُّكَ
سقطت سماءٌ
على السرير !!!»([14])
الكلمة الشّعرية ساحرة، ولطالما ارتبط الشِّعرُ بالسِّحر، والشِّعر سحرٌ وإنّهُ لكذلك، بل إنَّ الكلمة الشّعرية خالقة، خصبة لاسيما حين يتعلّقُ الأمر بالحبِّ، أحبُّك ويأتي العالم، أحبُّك ويغدو العالم في متناول اليد، إنَّهُ سحر الأنثى الذي يتقن الاستيلاء؛ فتصبح السماء قاب قوسين أو أدنى من الكائن، ليمتزج الأعلى بالأسفل، السماء بالسرير، إنَّهُ الحبُّ الذي يضيءُ الجسدَ بالجسد، فيحتفلُ العَالم ببهجة الموسيقى !!!.
([1]) ـــ جولان حاجي: ثمّة من يراك وحشاً، دمشق: إصدارات الأمانة العامة لاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، 2008.
([2]) ــ المصدر السابق، ص 17.
([3]) ـــ المصدر السابق، ص 88.
([4]) ــــ المصدر السابق، ص 9.
([5]) ـــ رائد وحش: لا أحد يحلم كأحد: إصدارات الأمانة العامة لاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، 2008.
([6]) ـــ المصدر السابق، ص9.
([7]) ـــ المصدر السابق: ص31.
([8]) ـــ المصدر السابق، ص 39.
([9]) ــ رشا عمران: معطف أحمر فارغ، دمشق: وزارة الثقافة، ط1، 2009.
([10]) ـــ المصدر نفسه، ص 5.
([11]) ـــ المصدر السابق، ص 124.
([12]) ـــ المصدر السابق، ص 22.
([13]) ـــ المصدر السابق، ص 85.
([14]) ـــ المصدر السابق، ص 119.








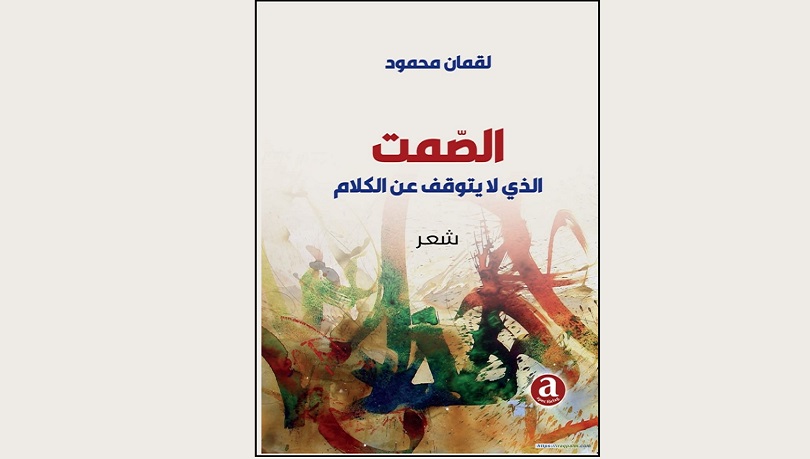
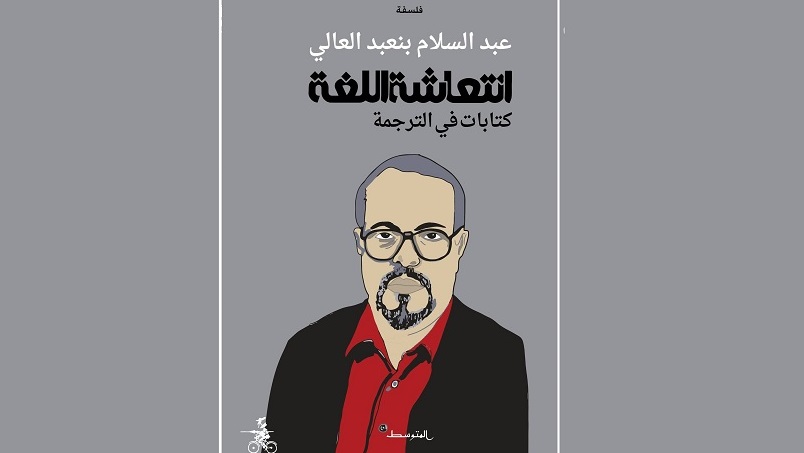
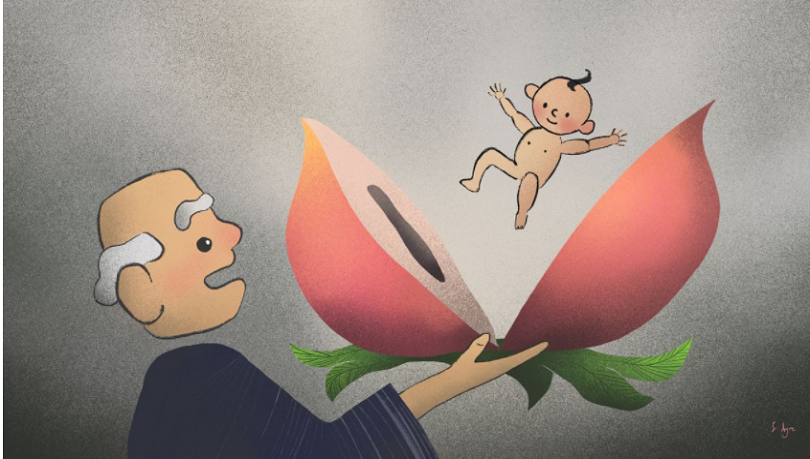
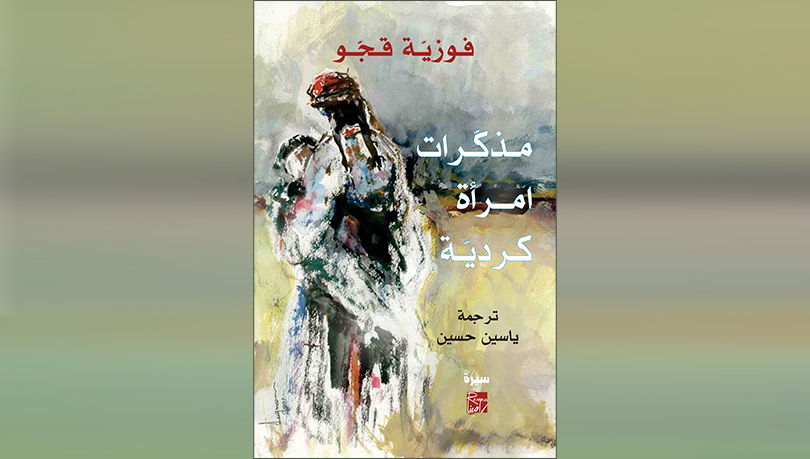





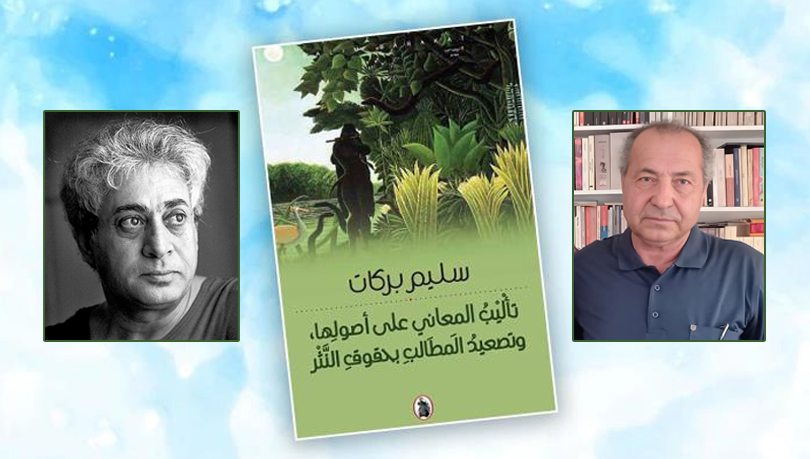
0 تعليقات