وليد عثمان
لم يعد شيء يؤرقني غير السؤال الذي لم يغادر عقلي منذ خمسين عاماً: ما جدوى كل هذه الرحلة التي تبدأ في ظلمة الرحم وتنتهي في ظلمة القبر؟
كثيرون اتهموني بكل سييء حين كنت أطرح هذا السؤال في حضرتهم، قليلون جداً من اعترفوا بأنه يشغلهم أيضاً، لكنهم لا يتوقفون عنده كثيراً؛ لأنهم عجزوا عن الإجابة عليه.
البعض آثر لي ولنفسه السلامة ورأى أنه لا جدوى من الانشغال بالسؤال، وأن الأولى بنا أن نستسلم لهذا القدر ونرضى بكل ما يقودنا إليه أو يبعدنا عنه.
لم يفهم أحدهم أبداً أنني لست معترضاً، لكنني أريد أن أفهم، أفهم فحسب.
لا أعاند القدر لكن نهايته المشتركة بين كل البشر: الموت ، هي التي تشغلني.
المعتاد أن نخرج من ظلمة بالميلاد، بعده، نتوزع في دروب الحياة وتفرقنا خطوطها وتجمعنا بلا اختيار منا، لكن بعد النهاية ماذا يحدث؟
لم يعد أحد من قبره ليروى لنا وقائع لياليه في ظلمته ولم نعرف على وجه اليقين ما يجري لهذا الجسد الذي فارقته الروح، وإن كان صاحبه يشعر بنا أم ينسانا كما ننساه.
هل الموت صعب؟
لا تهم الإجابة، فلا حيلة أمامه ولا معنى للخوف منه.
المؤكد أنه الحقيقة الثابتة التي نعرفها، فلم يفر أحد منه مهما قصر عمره أو طال؟
هل طول العمر يعني حظاً أوفر، أم أن قصره راحة مبكرة مادمنا مهما عشنا سنصل إلى النتيجة ذاتها؟
هل يجدي اجتهادنا في الدنيا وبلوغ بعضنا مجد السلطة أو المال؟ هل ندفع بعد الموت ثمن حماقاتنا وجرائمنا بحق أنفسنا والآخرين؟
الخلود الوحيد أن تبقى حياً وسط أحبابك تنهل من متع الدنيا أو تُعاقب على ما تقترفه يداك. ما الذي يفيد عبدالناصر أو الشعراوي أو هيكل بعد الموت؟ وما الذي يقلق أي لص أو قاتل أو سفاح أسال دم الملايين في حرب أو غيرها؟
الوعد والوعيد أمران لا ينفصلان عن المجهول الذي ينتظرنا بعد الموت، وكل تفاصيله المروية لنا لا نثق في تحققها.
أنا أمامكم الآن، بلغت التسعين بعد أن أفلتُ طويلاً من قبضة الموت الذي استمرأ أن يحيا في عائلتنا كضيف ثقيل أكرمناه وقدمنا له أجساد عدد من خيارنا، فأطال بقاءه.
ربما كنت محظوظاً بهذا البقاء، على الأقل طال استمتاعي بتفاصيل الحياة رغم قسوة بعضها.
لم أتمن الموت أبداً، فالذين يتوهمون أنه طريق إلى الراحة لم يقدموا لنا دليلاً على ذلك. حتى ألم المرض أهون من الحرمان من الحياة.
المهم أن تبقى حياً، مريضاً، سجيناً، سعيداً، تعيساً، أعزب، متزوجاً، أباً، عقيماً، ذكياً، غبياً، فقيراً، غنياً.
كل هذه الصفات التي نشغل أنفسنا بها لا تعني شيئاً ما لم نكن أحياء، فالموت يسخر دوماً من لهاثنا المتعب وصراعنا المهلك بحجة أننا نريد أن نزيد ما نملك أو نترك بصمة في الدنيا.
إن كنتم تقدرون، أحضروا الذين ملأوا الدنيا حضوراً واسألوهم إن كان ذلك حماهم من الموت أو نفعهم بعده. اسألوا من عاشوا فقراء أو على الهوامش إن كانوا تأذوا في قبورهم.
الأهم أن تعيش، لأنك بالموت تُنسى مهما ذهبت إليه محاطاً بدموع من حولك وادعائهم أنهم لن يعيشوا من بعدك..
سيعيشون من بعدك وسيعودون إلى حياتهم سريعاً، الفراغ الذي تركته سيشغله غيرك، والمرأة التي عشقت سينفتح قلبها لغيرك، والولد الذي خفت عليه من قسوة اليتم سيكبر ويحب ويتزوج، والمال الذي أنفقت عمرك في جمعه سيسكر به غيرك أو يواعد امرأة..
ستتحول بالموت إلى صورة باهتة مؤطرة بسواد تخف حدته مع الوقت، أو ذكرى على "الفيسبوك" تضمن بعض علامات الإعجاب أو التعليقات السنوية الخالية من الروح..
حضورك هنا في تفاصيل الدنيا هو ما يعنيك، فلا تفرط فيه ولا تشغل نفسك بما بعده..
لا تجادل الذي يحدثونك عن عمارة الأرض واستخلافك فيها وما ينتظرك بعدها، فالذين ماتوا أجنّة أو رضعاً لم يعمروا الأرض، والذي جاؤوها محرومين من العقل والإدراك وطاردتهم تهمة الجنون مروا بهم خفافاً بلا أثر، فلماذا عاشوا؟
اقبض على لحظة الدنيا، وهي لحظة لا أكثر، صدقوني كرجل عاش تسعين عاماً منشغلاً بالموت منذ عرفته هي لحظة لا أكثر.
الموت لص لا ينشغل باتهامكم له بسرقة الأحبّة والأوقات السعيدة، الموت بلا قلب، فلا يترك طفلاً لأمه، ولا أماً لصغيرها فيعصمه من اليتم، لا يعنيه ما يربط أباً بابنه.
الموت رسول لا يفكر ولا يراعي حرمة البيوت والأوقات، لكنه في كل مرة يأتي فيها ويمضي بمن جاء من أجله يبدل وجه الحيّاة التي يكرهها بلا سبب.
الموت يحرمك من أبيك أو أمك ويلقي بك في قبضة أخرى لرجل أو امرأة ترييك فتسعد معها أو تشقى، ينزعك من سريرك ويضع رجلاً آخر يقول ما قلته مراراً لامرأتك ويجد مثلك سبيلاً إلى داخلها، يطردك من عملك، فيصطف الذين هابوك طويلاً ونافقوك واتقوا غضبك أمام وجه جديد يعيدون معه الكرة.
الموت يحرمك من زفافك الذي جاهدت لتقيمه، وإذا ترك لك فرصة لحضوره يخطفك بعده مباشرة، وقد يأخذ معك عروسك..
هو حدث بلا منطق ولا عقل، لكنه في أوقات كثيرة يكون حلاً لمعضلات وإعادة ترتيب لأوضاع حسبتها لن تتبدل.
مرة أخرى، لا أخاف الموت وأعلم أني أقرب إليه الآن من أي وقت مضى، لكن ما يزعجني أني أقترب من النهاية ومعظم الذين عرفتهم في حياتي رحلوا.
هل من سخرية القدر أن الأموات أكثر حضوراً في حياتي الآن من غيرهم، أستعيد كل يوم سيرهم وتفاصيل حياتهم أو حياتنا معاً، بينما الأحياء الذين أعرفهم، على قلتهم، منشغلون بدنياهم.
لا ألومهم، ولا أنتظر منهم وداً؛ لأنه لن يطول.
ولست أسعى بمعرفتي بهم إلى وظيفة أو مال أو غيرهما من المنافع، ولا أنشد في قربهم تسرية عن النفس، فالأموات الحاضرون في تفاصيلي يتكفلون بهذه المهمة، وما بقي في روحي من مشاهد حياتهم يمنحني متعة لا تضاهي، لكنها، ككل شيء، لن تدوم.
متعة الحياة لا تعادلها متعة، فكل الوعود التي تطمئننا إلى ما بعدها محل شك.








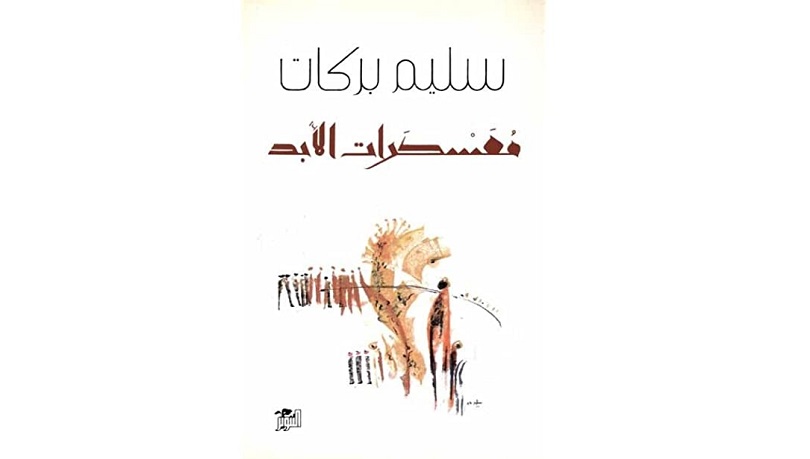
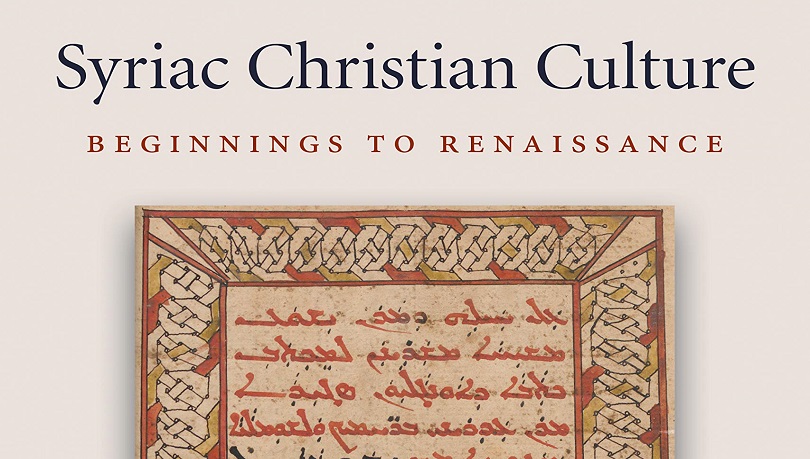



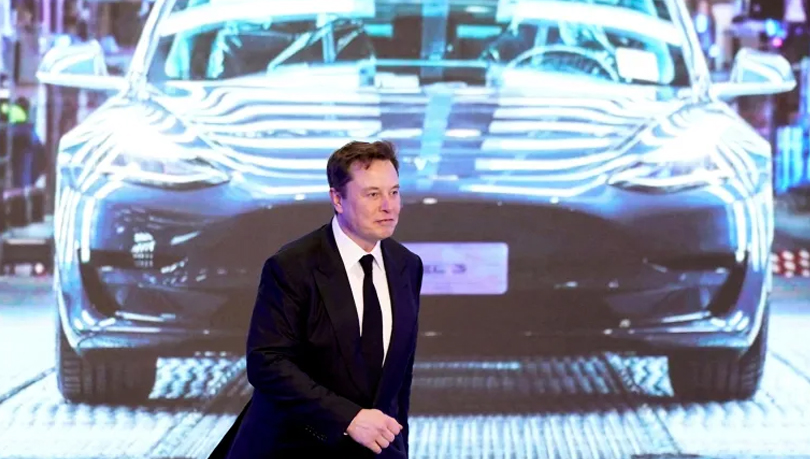



0 تعليقات