حواجز التاريخ أمام الأمن الأوروبي المشترك
منذ أن بدأت الولايات المتحدة في إعادة النظر في مشاركتها في السياسة العالمية، بدأت تنسحب استراتيجيًا من العديد من المناطق ولم تعد تفكر فيها، متجهة نحو المحيطين الهندي والهادئ، ولا سيما الصين، منافسها الحقيقي الوحيد في القيادة العالمية في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا السياق الجديد، ما الذي يجب أن تطمح إليه أوروبا؟ وهل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يسد على الأقل جزءاً من الفجوة الأمنية الناتجة عن الانسحاب؟
عندما يتعلق الأمر بصياغة سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، يتباطأ الاتحاد الأوروبي، مع أنه يتقدم بسرعة في خطاباته. وعلى الرغم من موقف الشكوكية الأوروبية الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب|، لمدة دامت أربع سنوات، والصعود العدواني المتزايد للصين، وسياسة الرجعية التي تعتمدها روسيا في أوروبا الشرقية، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التوقعات الأوروبية والواقع.
وباعتبار أوروبا واحدة من أغنى مناطق العالم وأكثرها تقدمًا في مجال التكنولوجيا، من المؤكد أنها تستطيع متابعة استراتيجيتها الدفاعية والأمنية. ومع ذلك، فإن التفكير الأوروبي لم يتَّحِد بعد وراء هذه الفكرة. إذ لا يزال للتجربة التاريخية ثقل كبير عليه، شأنها في ذلك شأن الافتراض الراسخ بأن أمريكا ستتدخل دائمًا إذا ساءت الأمور.
إن السبب الرئيسي وراء بقاء الاتحاد الأوروبي مشلولًا، بل غير كفء فيما يتعلق بقضايا السياسة الأمنية، يكمن في أكبر عضوين مؤسسين له وأكثرهما اكتظاظًا بالسكان، وهما ألمانيا وفرنسا. إن هاتين الكتلتين الثقيلتين (نسبيا) لهما نفس الإمكانات الإستراتيجية تقريبًا. وبدونهما، لا يمكن عمليا أن يحدث أي شيء من حيث السياسة الأمنية. وعلى الرغم من الحاجة إلى توافق في الآراء بين جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين لتحقيق أي تقدم حقيقي نحو إطار أمني مشترك، فإن فرنسا وألمانيا هما العضوان الوحيدان اللذان يمتلكان الموارد اللازمة لتحويل رؤية جديدة إلى واقع جديد.
ولكن العادات القديمة لا تموت بسهولة. إذ خلال أربعة عقود من الحرب الباردة، اعتمد قادة أوروبا الغربية على ضمان أمني أمريكي تَضَمَّن وجودًا عسكريًا كبيرًا في قلب أوروبا، وقدرة على توجيه ضربة نووية مضادة للرد على هجوم يشنه حلف "وارسو". وعلى الرغم من أن الحرب النووية كانت ستحول جزءا كبيراً من أوروبا إلى كومة من الأنقاض المشعة، إلا أن هذا الترتيب يضمن السلام في المنطقة. وساهمت أوروبا الغربية بقواتها من خلال الناتو، لكنها ظلت معتمدة كليًا على الولايات المتحدة، حتى بعد انتهاء الحرب الباردة.
وتتمثل إحدى المشكلات في أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحادًا فيدراليًا مع حكومة مركزية واحدة، بل هو اتحاد كونفدرالي يتكون من دول ذات سيادة، ولكل منها طابع تاريخي مميز يوجه سياستها الأمنية. ولا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من العلاقة الفرنسية الألمانية. فكلا البلدين قريبان جدًا من بعضهما البعض جغرافيًا وتاريخيًا، ومع ذلك لا يزالان متباعدين جدًا في المسائل الأمنية- لدرجة أنه يمكن اعتبارهما متناقضين إلى حد ما.
ولم يفسح العداء الذي دام قرونًا بين الألمان والفرنسيين المجال للتعاون والصداقة إلا بعد أن دُمرت ألمانيا، واحتُلت من قبل قوات الحلفاء، وانقسمت في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي العقود التي تلت ذلك، وجدت أوروبا السلام أخيرًا، وأحرزت تقدمًا نحو تكامل أعمق ونظام قانوني مشترك- كل ذلك تحت حماية المظلة الأمنية للولايات المتحدة.
ولكن التاريخ لا يزال يخيم بظله الكبير على المواقف الفرنسية والألمانية تجاه السياسة الأمنية. وبالنسبة لفرنسا، فهي لا تزال تعتبر قوة أوروبية عظمى بفضل أسلحتها النووية، ومقعدها الدائم (وحق النقض) اللذين تتمتع بهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وأقاليمها ما وراء البحار في المحيط الهادئ والمحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي؛ ووجودها في غرب إفريقيا.
وبالمقابل، تخلت ألمانيا عن طموحاتها في تحقيق القوة العظمى بعد محاولتيها الكارثيتين الفاشلتين للسيطرة على العالم في القرن العشرين. إذ بغض النظر عن الأحزاب الموجودة في السلطة، لا تستخدم الحكومات الألمانية الأصول العسكرية وتصدير الأسلحة كأدوات للسياسة الخارجية، مما يفسح المجال أمام الولايات المتحدة لتستخدم أدوات القوة الصارمة هذه. ولازال الانعطاف العكسي السلمي الذي قامت به ألمانيا بعد الحرب يحدد تصورها الذاتي على وجه التحديد، لأنه أسفر عن هذه النتائج الإيجابية. ومن خلال التركيز على الاقتصاد، والسلام، وإعادة التوحيد المنظم (في نهاية المطاف)، أصبحت ألمانيا قصة نجاح حديثة.
ويمكن لفرنسا أن تكون ممتنة ل"شارل ديغول" لأنها لازالت تُعرف نفسها على أنها قوة أوروبية عظمى. إذ على الرغم من هزيمتها في عام 1940، وإنهاء الاستعمار بعد الحرب، والخلاف الجزئي مع الولايات المتحدة بشأن الناتو، لم يتغير تصور فرنسا الأساسي لنفسها. ومن ناحية أخرى، تدين ألمانيا بعودة ظهورها بعد الحرب إلى قطيعة حاسمة مع تاريخها، التي اعترفت بمسؤوليتها التي لا لبس فيها عن أحداثه. وكان وجود الولايات المتحدة وضماناتها الأمنية عاملين حاسمين في إعادة التقييم هذه.
ومع ذلك، بينما تعكس فرنسا وألمانيا المعاصرة المسارات التاريخية التي سلكتاها، إلا أنهما تعتمدان على بعضهما البعض. إذ في النهاية، تتوافق مصالحهما الوطنية مع مصالح الاتحاد الأوروبي، لأنهما إما سيغرقان أو يسبحان معًا. ولا توجد بدائل ممكنة، خاصة إذا كان الضمان الذي توفره أمريكا لأوروبا يتعثر.
وفي هذا السياق، سيتطلب تطوير سياسة أمنية ودفاعية مشتركة تنازلات هائلة بين مختلف الفئات التي تتألف منها الأسرة الأوروبية، والتي ستظل تجاربها وصدماتها التاريخية، التي تختلف اختلافا جذريًا، أكبر العوائق أمام التقدم. ولن تتمكن أي تسوية كبرى في النهاية من التوفيق بين وجهات النظر الفرنسية والألمانية. وستعكس هذه العملية عملية تفاوض مستمرة- وربما دائمة. وهذه هي الطريقة الوحيدة لجعل أوروبا تعمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمنية.
المصدر: بروجيكت سنديكيت ترجمة: نعيمة أبروش







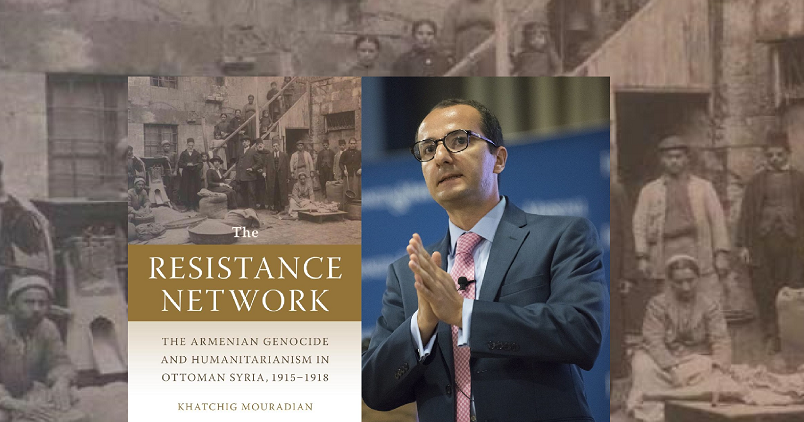









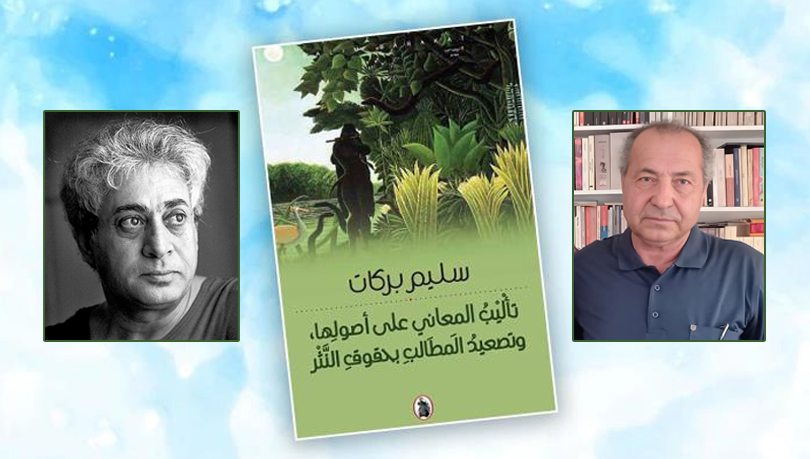
0 تعليقات