ترفرف اللغة الكردية بجناحيها في القرى المتناثرة على الحدود التركية السورية، من عامودا إلى الحسكة ومن دير يك إلى الدرباسية، وبينها وحواليها تل كوجر والقامشلي ورأس العين وكوباني وعفرين. الحدود مسطرة بخط سكة قطار الشرق السريع الذي حاول المفتش هيركول بوارو فك طلاسم الجريمة التي وقعت فيه والتي "اقترفتها" أغاثا كريستي. هناك يتكلم الناس والطيور والأشجار والعناكب واللقالق والأعشاب اللغة الكردية. القرية الصغيرة، كرنكو، قريتي، تفعل الشيء ذاته.
صغيراً، كنت أعتقد أن الأمر هكذا في كل مكان. أن البشر كلهم يتكلمون اللغة التي أتكلم بها. لم أكن أعرف أن الكلام له اسم. أنه لغة. أعني أنني كنت أعتبر أن الناس تتكلم بهذا اللسان لأنه شيء طبيعي تماماً مثلما تزقزق العصافير وتصفر الريح.
في البيت كان أهلي يمارسون طقوساً معينة: يتوجهون للشمس صباحاً ويشكرون الرب ويرددون أسماء مثل خودي وطاووس ملك وشيشمس ويصومون ثلاثة أيام في السنة، في شهر تشرين الثاني. وهذا حال الإيزيديين. كان هذا أيضاً، في نظري، من طبيعة الأشياء. غير أني لم أكن أعرف أن الأمر يتعلق بدِين اسمه الدِّين الإيزيدي. كان في ظني أن البشر كلهم يفعلون ذلك لأن هكذا هي الدنيا. باختصار كان الناس كلهم، في نظري، أكراداً وإيزيديين. وكان هذا الشيء يخلق عندي شعوراً بالأمان والطمأنينة. ثم كبرت وبدأت الحياة تلقنني الدروس الصعبة.
جاء إلى القرية معلم للمدرسة التي بُنيت تواً. وقف المعلم عند اللوح ونحن في مقاعدنا، مكتوفي الأيدي، نترقب ما سيقوله لنا. بدأ يتكلم. لم أفهم كلمة واحدة مما قاله. اعتقدت أن هناك خطأ ما: إما أن المعلم كائن خرافي، لا ينتمي لفصيلة البشر، الذي في حسبي أنهم يتكلمون باللسان ذاته الذي أفهمه، أو أننا، نحن في القرية، نعاني قصوراً ما. عرفت، في ما بعد، أنه يتكلم لساناً آخر. لغة أخرى. وعرفت أنه جاء إلينا كي يعلمنا هذه اللغة. سيعلمنا أن نقرأ ونكتب ونتحدث بهذه اللغة. هناك لغات في الدنيا، إذن، غير اللغة الكردية. لكن لماذا أرسلوا إلينا معلماً يتكلم لغة لا نفهمها؟ لماذا لم يرسلوا معلماً يتكلم مثلنا؟ نحن، الطلاب، أكراد، والمعلم وحده عربي، وعلينا أن نرضخ له فنتعلم اللغة التي جاء بها إلينا. علينا أن نزيح جانباً اللغة التي فتحنا عيوننا ومسامعنا عليها، ونهملها، ولا نكتب أو نقرأ بها، بل حتى لا نتحدث بها، ونكرس الجهد والوقت والذهن لتعلم اللغة الجديدة. الأهالي، كلهم، يتكلمون الكردية، فيما العربية تفرض نفسها في المدرسة والمخفر وشعبة التجنيد.
ما المنطق في ذلك؟ من قرر أن تكون الأمور على هذا النحو؟ لم نطرح الأسئلة لأننا اعتبرنا أن الدنيا هكذا. لم يكن في قاموسنا كلمات تشرح معنى ما يجري على أرض الواقع. كان علينا أن نتكيف مع ذلك كما لو أنه شيء بديهي. كان الأمر أشبه بإعادة صياغة كينوناتنا، بخلقنا من جديد، بهندسة أذهاننا وأفكارنا وتشذيب مشاعرنا وأحاسيسنا. كانوا ينزعون قشدة الفرح من أعمارنا ويزيحون اللب من ثمار أغنياتنا ويشنقون ضحكاتنا. كانوا يهيئون لنا ذاكرة جديدة تتناسب مع اللغة الجديدة: ذاكرة العروبة. وكنا نردد كل صباح ودون أي تذمر: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.
ثم جاءت، بعد سنة أو اثنتين، حصة "التربية الإسلامية". كنا تعلمنا القراءة. كان علينا أن نحفظ آية عن ظهر قلب. بدأ المعلم من عند ابن عمي، هادال، وطلب إليه أن يقرأ. شرع هادال في القراءة، لكنه بدأ بالبسملة فوراً. طلب إليه المعلم أن يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفض ابن عمي لأن الدين الإيزيدي يمنع بشكل صارم التلفظ بكلمة الشيطان. رغم إصرار المعلم استمر هادال في الرفض. حمل المعلم عصا الخيزران وبدأ ينهال بها، بضربات رهيبة، على يد هادال. حين استدار المعلم كي يلتقط أنفاسه تمهيداً لإستئناف الضرب، هرب ابن عمي من المدرسة. لم يعد إليها أبداً. آنذاك عرفت أن الناس ليسوا مثل أهلي. أن هناك ممارسات وقناعات أخرى تسمى الدين. عرفت آنذاك أنني إيزيدي وأننا نتوجه للشمس ونصوم ثلاثة أيام ونشكر الرب وطاووس ملك وشيخادي شيشمس، لأننا إيزيديون. عرفت لماذا نحتفظ في البيت بإبريق نحاسي وحصيرة صغيرة: للوضوء والصلاة لضيوفنا من المسلمين. عرفت، إذن، انني إيزيدي وأن المعلم مسلم. لم أسأل نفسي لماذا تُفرض علينا نصوص وآيات وأفكار دين آخر غير ديننا؟ لماذا لم يرسلوا لنا معلماً يشرح لنا أصول ديننا الإيزيدي؟ لم أطرح، ولا غيري، هذه الأسئلة لأننا اعتبرنا أن هكذا هي حال الدنيا.
تهاوى في داخلي الشعور بالأمان وبدأت أشعر بالهشاشة.
اللغة العربية التي تعلمناها في المدرسة كانت مثل السوط ينهال به المعلم على رؤوسنا والدين الإسلامي الذي فرضه علينا المعلم، كان إكراهاً مرعباً يشعل في أعماقنا غضباً مكبوتاً وقهراً لا يلين. ألم يكن من الممكن أن يعلموننا اللغة الكردية واللغة العربية جنباً إلى جنب؟ ألم يكن ممكناً أن يعلموننا الدين الإيزيدي إلى جانب الدين الإسلامي؟ لماذا كان يجب أن نحرم من لغتنا الأم وديننا الخاص؟
كان علينا أن نحني أعناقنا ونغمض عيوننا ونعيد ترتيب أدعيتنا وتراتيلنا وصلواتنا، وأن نخبئ تعلقنا بطاووس ملك وشيخادي وسيشمس. كان علينا أن نكون مثل أوراق يابسة، بلا روح أو صوت أو رغبات. كان علينا أن نكون لا شيء. أن لا يبدر منا أي سلوك "يفضح" حضورنا الإيزيدي ولا تطلع من أفواهنا كلمة تحمل صبغة إيزيدية. كان يلاحقنا على الدوام رذاذ السخرية والإستهزاء والإدانة والتقريع، بوعي أو من دون وعي.
ثم تلقيت درساً آخر من خارج المدرسة، حين كنت مع أبي في عامودا. مرت بالقرب منا امرأة وحين رأت أبي صرخت: يابو، إيزيديه. وهربت كما لو أنها رأت جنّياً. لا أعرف كيف عَرَفت أن والدي إيزيدي (ربما من شاربيه، فالإيزيديون لا يحلقون شواربهم، مثل الدروز). نظرتُ إلى أبي فلاحظت في عينيه الخذلان والإنكسار. غطى وجهه لون رمادي وبدا كما لو نهض تواً من القبر. كنتُ صغيراً، لكن حزناً طاغياً سيطر علي. لا أستطيع، حتى الآن وقد بلغت من العمر عتياً، أن أنسى وجه أبي في تلك اللحظة. كانت المرأة كردية، بالطبع، فأهل عامودا كلهم أكراد. آنذاك عرفت أنه يمكن أن تكون كردياً، وفي الوقت نفسه منبوذاً من الأكراد لأنك لا تنتمي للدين الذي ينتمون إليه. ثم تعزز هذا اليقين عبر الموت، حين انتحر أخي. كان يكبرني بسنوات. أقنعوه أننا كفار وأننا سنذهب إلى النار. أبي وأمي وأخوتي، وكل أهل القرية سيدخلون جهنم لأنهم كفار. سعوا في أن يقنعوه لأن يتخلى عن أهله ويترك دينه. كان أخي مراهقاً في بداية العمر. لم يتحمل. انتحر.
في كتاب "الفتاة الأخيرة" تروي نادية مراد، التي خطفها تنظيم "داعش"، أنها اتصلت بمعلم اللغة العربية الذي كان يدرسهم في قريتهم، كوجو، كي يساعدها، هي وأهلها، على الهرب لئلا يقعوا في أيدي "داعش". أنكر المعلم معرفته بها وتخلى عنها وعن أهلها وبدا أنه يقف مع التنظيم الإرهابي.
أحياناً أسأل نفسي: لو أن "داعش" وصل إلى عامودا والقرى المحيطة بها، بما فيها قريتي، كرنكو، التي قضيت طفولتي فيها، أكان معلمو المدرسة والتربية الإسلامية وقفوا مع التنظيم الرهيب وسعوا في ترك الأهالي، الإيزيديين، لمصيرهم الرهيب؟ أكانت تلك المرأة التي فرت هاربة من أمام أبي، لأنه إيزيدي، عمدت إلى الوشاية به وبغيره من الإيزيديين عند "داعش"؟
المصدر: المدن






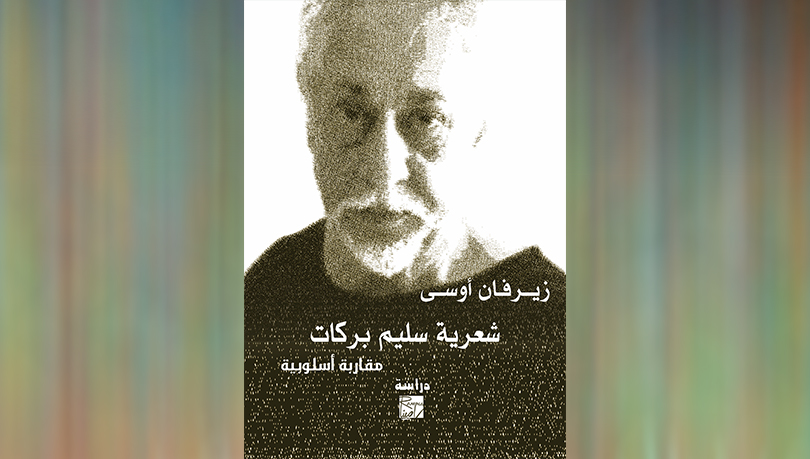
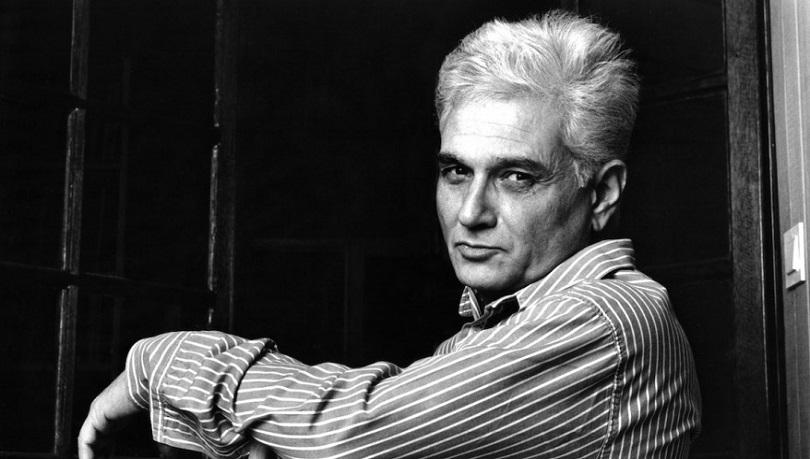









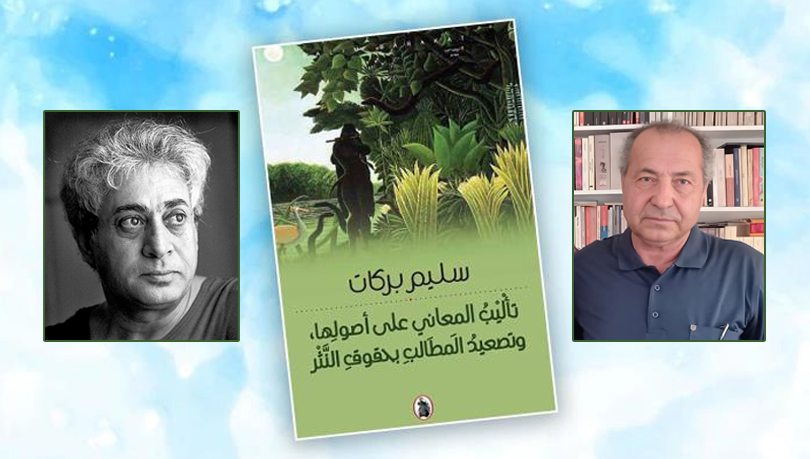
0 تعليقات